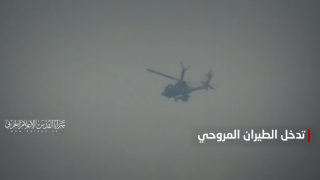رام الله - خاص قدس الإخبارية: صوّت كنيست الاحتلال بالقراءة الأولى، وأغلبية 71 عضوا، اليوم الأربعاء، على قانون فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية. لم يكن هذا التصويت معزولا عن النقاش "الإسرائيلي" الداخلي الذي تصاعد حول هذه القضية في السنوات الأخيرة، نظرًا لما ينطوي عليه من تحول جذري في طبيعة الصراع. فالخطوة ليست مجرد تغيير إداري أو توسيع للصلاحيات القانونية، بل تمثل إعادة تعريف لطبيعة العلاقة بين "إسرائيل" والأراضي المحتلة، وتضع نهاية عملية لمرحلة "الإدارة المؤقتة" التي استمرت منذ عام 1967.
تأتي هذه الطروحات في سياق تحولات عميقة، حيث تعزز نفوذ التيار الديني القومي، وأصبحت رؤيته حول "أرض إسرائيل الكاملة" جزءًا من السياسات الحكومية الفعلية. بالتوازي، يواجه النظام الدولي المأزوم تحديًا حقيقيًا في كيفية التعامل مع دولة تفرض وقائع أحادية الجانب على الأرض، بما يتناقض مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.
يشير مفهوم فرض السيادة إلى إخضاع مناطق محددة في الضفة الغربية للقوانين المدنية والإدارية "الإسرائيلية"، بحيث يتم إنهاء العمل بالأنظمة العسكرية التي حكمت هذه المناطق منذ عام 1967. ويُعد هذا المفهوم في جوهره آلية لتوسيع الولاية القانونية لـ"إسرائيل" دون الحاجة إلى مفاوضات أو اتفاقيات. وعلى الرغم من التسمية التي تبدو أقل حدة من "الضم"، فإن الأثر الفعلي للخطوة واحد، وهو تكريس السيطرة "الإسرائيلية" بشكل دائم.
تجارب سابقة، مثل فرض القانون "الإسرائيلي" على شرق القدس وهضبة الجولان، أظهرت أن هذه الإجراءات لا تُغير شيئًا في الموقف الدولي، لكنها تخلق واقعًا يصعب التراجع عنه مستقبلاً. ومن منظور "إسرائيلي"، فإن هذه الخطوة تسعى أيضًا إلى تطبيع الوجود الاستيطاني وتحويله من مشروع مؤقت إلى أمر واقع مستمر.
من الناحية النظرية، يختلف فرض السيادة عن الضم في كون الأخير يتطلب عادة إعلانًا سياسيًا رسميًا واعترافًا دوليًا، في حين يكتفي الأول بتوسيع صلاحيات "إسرائيل" على الضفة. إلا أن هذا الفرق إجرائي أكثر منه جوهري؛ فالنتيجة واحدة: إخضاع الأراضي المحتلة للسيادة "الإسرائيلية" بشكل دائم. هذه الصيغة (فرض السيادة) تمنح "إسرائيل" مرونة أكبر أمام الضغوط الدولية، حيث يتم تسويق الخطوة على أنها "إجراء داخلي" لا يتطلب مفاوضات، في حين يتم تفادي المصطلحات التي تثير حفيظة المجتمع الدولي. وتكمن خطورة هذا النهج في كونه يجعل السيطرة الاستيطانية أكثر رسوخًا.
ولا يمكن النظر إلى فرض السيادة بمعزل عن الاستراتيجية الأشمل لإدارة الصراع. تبقى السيطرة الأمنية والإدارية على الأرض بيد "إسرائيل"، بينما يُترك للفلسطينيين هامش ضيق لإدارة شؤونهم المدنية. هذه الصيغة تعيد إنتاج النموذج الذي طُبق في القدس بعد عام 1967، حيث تم دمج الأرض دون دمج السكان بشكل كامل. عمليًا، يشكل فرض السيادة مرحلة متقدمة من مشروع الضم الزاحف الذي بدأ منذ عقود، ويهدف إلى تفتيت الضفة إلى معازل سكانية فلسطينية غير متصلة، مقابل توسع استيطاني متسارع. هذا الواقع يُصعّب إمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات على أساس حدود 1967، ويجعل أي حل سياسي مستقبلي أكثر تعقيدًا وتكلفة من الناحية الديموغرافية والأمنية.
في السياق "الإسرائيلي" الداخلي، يمثل فرض السيادة أداة لتعزيز شعبية الحكومة اليمينية، خاصة في ظل المنافسة بين الأحزاب على تمثيل المستوطنين والتيار الديني القومي. أحزاب مثل "الليكود" و"الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" ترى في هذه الخطوة اختبارًا لمصداقيتها أمام جمهورها، الذي يطالب بتحقيق وعود "أرض إسرائيل الكاملة". بالنسبة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، فإن الخطوة تمنح فرصة لإعادة ترتيب أولويات الأجندة السياسية وصرف الأنظار عن الأزمات الداخلية. كما أنها تخلق تماسكًا مؤقتًا داخل الائتلاف، خصوصًا مع الشركاء الأكثر تطرفًا الذين يضغطون لتسريع الخطوات الاستيطانية. ولطالما استخدمت حكومات "اليمين" قضايا السيادة لتعزيز بقائها عبر كسب دعم التيارات الدينية والقومية.
بالنسبة للتيار الديني القومي، وخاصة أتباع مدرسة الحاخام تسفي يهودا كوك، فإن السيطرة الكاملة على الضفة الغربية ليست مجرد مسألة سياسية، بل هي واجب ديني مرتبط بتحقيق الوعد التوراتي. هذا التيار يرى في فرض السيادة خطوة ضمن مشروع "أرض إسرائيل الكاملة" الذي يمثل جوهر رسالته العقائدية. هذه الرؤية تستند إلى مفهوم "بداية الخلاص"، الذي يعتبر التوسع الإقليمي تجسيدًا لإرادة إلهية تسبق مجيء الخلاص الكامل. بناءً عليه، فإن أي تنازل عن الأرض يُعد تعديًا على الإرادة الإلهية، وهو ما يفسر المعارضة الشديدة داخل هذا التيار لأي خطة سلام تتضمن انسحابًا من المستوطنات أو تقسيمًا للأراضي.
لم تعد هذه الرؤية محصورة في الحلقات الدينية، بل انتقلت إلى مراكز صنع القرار السياسي. إذ يشغل خريجو المدارس الدينية القومية مناصب بارزة في الحكومة والكنيست والجيش، مما جعل الخطاب المشيحاني جزءًا من السياسات الرسمية.
الأحزاب اليمينية التي تتبنى هذه الرؤية تدفع نحو تشريعات توسع الاستيطان وتمنح الأفضلية للمستوطنين في التخطيط الإقليمي. كما يتم توظيف الرموز الدينية في الحملات الإعلامية لتبرير السياسات الاستيطانية وتقديمها كجزء من تحقيق النبوءة التوراتية. هذه النزعة تعيد تشكيل الهوية الوطنية "الإسرائيلية" لتصبح أكثر ارتباطًا بالتصورات اللاهوتية، وهو ما يثير مخاوف المجتمع الدولي من أن تتحول "إسرائيل" إلى دولة ذات طابع ديني-قومي أكثر تشددًا.
على المستوى الإقليمي، يُنظر إلى هذه الرؤية باعتبارها تصعيدًا للصراع الديني في المنطقة. فتبني خطاب توراتي يربط الأرض بالوعد الإلهي يهمش أي أفق لحل سياسي قائم على التفاوض، ويُعمّق الهوة بين "إسرائيل" وجيرانها العرب. كما أن هذه النزعة تثير مخاوف لدى الأردن من تهديد الوضع الخاص للأماكن المقدسة في القدس، وتزيد من احتمال اندلاع مواجهات دينية في الحرم القدسي الشريف. ووفقًا لدراسة معهد دراسات الأمن القومي، فإن توظيف البعد المشيحاني في السياسات "الإسرائيلية" سيؤدي إلى زيادة الاحتقان الديني، وقد يشعل موجات من العنف يصعب احتواؤها، مما يجعل فرض السيادة ليس مجرد قضية داخلية، بل ملفًا إقليميًا ودوليًا بامتياز.
دوليًا، أثارت خطط الضم السابقة في 2020 ردود فعل حادة من الاتحاد الأوروبي، الذي لوّح بفرض عقوبات اقتصادية، ومن الأمم المتحدة التي اعتبرت الخطوة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. أما الولايات المتحدة، فإن موقفها متغير تبعًا للإدارة الحاكمة: إدارة ترامب منحت ضوءًا أخضر ضمنيًا لهذه الخطط ضمن "صفقة القرن"، بينما عادت إدارة بايدن لتؤكد تمسكها بحل الدولتين ومعارضتها لأي ضم أحادي، واليوم عاد ترامب بنفس الرؤية.
ووفق تقرير خدمة العمل الخارجي الأوروبي (2021)، فإن أي خطوة "إسرائيلية" لفرض السيادة قد تدفع دولًا أوروبية إلى مراجعة اتفاقيات التعاون الاقتصادي مع "إسرائيل". كل ذلك يضع حكومة نتنياهو أمام معادلة معقدة: تحقيق مكاسب سياسية داخلية مقابل تحمل كلفة العزلة الدولية وتراجع العلاقات مع حلفائها التقليديين. لكن من الواضح أن نتنياهو يقدّم الأولى على الثانية.
ويتطلب فرض السيادة من الناحية القانونية تشريعًا من الكنيست (وهو ما بدأ اليوم) لتمديد سريان القوانين المدنية إلى المناطق المستهدفة. هذا يعني إنهاء دور الإدارة المدنية التابعة للجيش وتحويل القضايا الإدارية والقانونية إلى الوزارات والمحاكم المدنية "الإسرائيلية". النتيجة المباشرة هي تغيير جذري في منظومة الحكم، حيث تصبح المستوطنات والطرق المحيطة بها خاضعة لإدارة مدنية كاملة، ما يرسخ الوجود الاستيطاني ويمهد لتوسيعه.
هذه الخطوة ستؤثر كذلك على الفلسطينيين القاطنين في هذه المناطق، إذ سيتحولون إلى سكان "مقيمين" تحت السيادة "الإسرائيلية" دون أن يتمتعوا بحقوق المواطنة الكاملة، مما يعيد إنتاج النموذج المطبق في شرق القدس. هذا الإجراء يعكس أيضًا التوجهات الجديدة لحكومة نتنياهو التي تسعى إلى دمج أكبر قدر من الأرض بأقل عدد ممكن من السكان الفلسطينيين.
وفقًا للقانون الدولي، تُعد الأراضي التي احتلتها "إسرائيل" عام 1967 أراضي محتلة، وأي تغيير في وضعها القانوني يُعد باطلاً وغير شرعي. تنص المادة الثانية من اتفاقية جنيف الرابعة على حظر الضم الأحادي للأراضي المحتلة، كما أكدت محكمة العدل الدولية (2004) في رأيها الاستشاري حول الجدار الفاصل أن الضفة الغربية تظل أرضًا محتلة وأن المستوطنات غير قانونية.
إضافة إلى ذلك، اعتبر تقرير مجلس حقوق الإنسان (2022) أن الضم الأحادي قد يرقى إلى جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. مثل هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام تحقيقات جنائية دولية ضد مسؤولين "إسرائيليين"، وتزيد من عزلة "إسرائيل" القانونية على الساحة الدولية.
التداعيات القانونية لفرض السيادة لا تقتصر على الجانب الدولي، بل تمتد لتشمل العلاقات الثنائية مع دول صديقة. إذ قد تدفع هذه الخطوة بعض الدول إلى تعليق اتفاقيات التعاون أو إعادة النظر في مكانة "إسرائيل" ضمن الأطر متعددة الأطراف. داخليًا، سيخلق فرض السيادة تحديات أمام المنظومة القضائية "الإسرائيلية"، خاصة فيما يتعلق بملكية الأراضي وحقوق السكان الفلسطينيين. فقد تتزايد الالتماسات أمام المحكمة العليا ضد مصادرة الأراضي الخاصة.
وبحسب موقف سابق لمركز عدالة، فإن هذه الخطوة ستعمّق نظام التمييز القانوني القائم بين المستوطنين والفلسطينيين، مما يجعل "إسرائيل" أكثر عرضة لاتهامات بتكريس نظام فصل عنصري بحكم القانون، وهو ما قد تكون له تبعات خطيرة على مكانتها الدولية.
إذا فُرضت السيادة "الإسرائيلية" على أجزاء واسعة من الضفة، ستفقد السلطة الفلسطينية السيطرة الفعلية على تلك المناطق، مما سيؤدي إلى تآكل دورها الإداري والأمني. هذه الخطوة قد تعني انتهاء المرحلة الانتقالية التي نصت عليها اتفاقيات أوسلو، وتحويل السلطة إلى كيان بلا وظيفة حقيقية سوى إدارة الشؤون المدنية في المعازل السكانية الفلسطينية.
في حال توسعت السيادة "الإسرائيلية"، قد تتجه السلطة إلى خيار التفكك الطوعي، مما سيعيد المسؤولية الكاملة عن إدارة شؤون السكان إلى "إسرائيل". هذا السيناريو، قد يُستخدم كورقة ضغط لإجبار المجتمع الدولي على التدخل. بديل آخر هو تحول السلطة إلى إدارة محلية بلا طابع سياسي، تُشرف على الخدمات المدنية فقط ضمن نظام أقرب للحكم الذاتي المحدود.
في كلا الحالتين، ستفقد السلطة دورها كفاعل سياسي يمثل مشروع الدولة الفلسطينية، وتتحول إلى أداة في يد الاحتلال لإدارة السكان.
تداعيات الخطوة لن تقتصر على البنية الإدارية، بل ستمس الشرعية السياسية للسلطة الفلسطينية أمام شعبها والمجتمع الدولي. داخليًا، سيُنظر إلى استمرار عمل السلطة تحت السيادة "الإسرائيلية" على أنه تواطؤ مع الاحتلال، مما سيعزز شعبية الفصائل المعارضة ويزيد من احتمالات اندلاع احتجاجات واسعة. دوليًا، سيضعف أي اعتراف بالسلطة ككيان يمثل الشعب الفلسطيني، خاصة إذا تحولت إلى إدارة محلية بلا سلطة سياسية. هذا الواقع قد يدفع المجتمع الدولي إلى البحث عن أطر بديلة لتمثيل الفلسطينيين، بما في ذلك إعادة تفعيل دور منظمة التحرير أو إنشاء آليات وصاية دولية على بعض المناطق.
ويمثل فرض السيادة خطوة متقدمة نحو تكريس واقع الدولة الواحدة التي تسيطر فيها "إسرائيل" على الأرض والسكان مع الإبقاء على نظام قانوني تمييزي ضد الفلسطينيين. وفق تقرير مركز كارنيغي (2022)، فإن هذا النموذج سيؤدي إلى تحول "إسرائيل" إلى دولة ذات نظام فصل عنصري بحكم القانون، وليس فقط بحكم الأمر الواقع. هذه الصيغة ستجعل أي مفاوضات مستقبلية أكثر تعقيدًا، لأنها تنقل الصراع من نزاع حدودي إلى صراع على الحقوق المدنية والسياسية ضمن دولة واحدة.
حتى إذا أبقيت جيوب فلسطينية تحت حكم ذاتي محدود، فإن التواصل الجغرافي والديمغرافي لأي دولة فلسطينية مستقبلية سيتلاشى. وتعتبر تقارير الأمم المتحدة أن هذه الخطوة ستجعل حل الدولتين "غير قابل للتطبيق عمليًا"، وتفتح الباب أمام المطالبة الدولية بمنح الفلسطينيين حقوق المواطنة الكاملة في دولة ثنائية القومية. هذا التحول سيقوض الإجماع الدولي الذي ظل قائمًا لعقود حول أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع.
بتآكل إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، سيتحول الصراع في نظر المجتمع الدولي من نزاع إقليمي إلى قضية حقوق مدنية ضمن دولة واحدة تفرض نظامًا تمييزيًا على جزء من سكانها. هذا سيزيد من الضغوط على "إسرائيل" من قبل منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الأممية، وقد يدفع بعض الدول إلى تبني سياسات عقابية شبيهة بتلك التي فُرضت على نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. بالتوازي، سيُعاد تعريف الدور الفلسطيني من المطالبة بالاستقلال الوطني إلى المطالبة بالحقوق المتساوية.