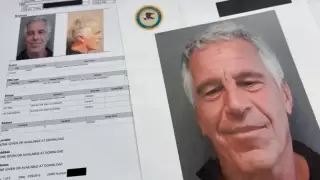إلى الأردن
الملك حسين يشعل السيجار لـــ رابين على جسر "اللنبي".. هكذا يستقبل زوّار مملكته، بين وجوه الغرباء المهووسين بتفتيش الحقائب والكلام. والفلسطينيّ نحو الصورة "منكسرًا" بصره، وطاويًا في جيبه وهم الرجوع إلى البلاد ووهم العروبة والجيوش الحافلة.
هنا بدأت الرحلة يا صديقي، أما المسير من رام الله لأريحا ومن معبر "الكرامة" إلى "اللنبي"، فليس بالشيء الذي يذكر، البدايات يجب أن تكون مؤثرة، صادمة أحيانًا، أو مرتبكة، وهناك، حيث نقف بانتظار فحص جوازات السفر الموقعة "رغمًا عنّا" بأوسلو، كنت أراجع في مخيلتي نصّا قديمًا لك، كتبته على عجل في زيارتك الأخيرة لعمّان، وأتصوّر شكل ابتسامتك أمام غضب الجندي الإسرائيلي المحصّن بالزجاج، في توقع "مواجهة" بيني وبينه، ربما لأنني في تلك اللحظة كنت أريد أي شرارة في هذا اللقاء الذي لا يحدث كل يوم معي، كي أشعل هذه الحواجز، أو يخترقني الرصاص.. لا تصدق، هذا اندفاع الجبناء لا أكثر، لم أقو على أكثر من "كشرة" في وجوههم.
هذه "الكشرة" كانت القاسم المشترك بين صوري في الهوية وجواز السفر والجسد الواقف قبالة جندي احتار في أمر الصور، وعلى ما يبدو في العبرية، طلب من زميله تفحّص ملامحي للتأكد من التطابق، لأن الثاني وجه بصره نحوي والوثائق بين يديه بالتناوب، حتى تم التأكد.
ما أغاظني في هذه المسافة بين فلسطين والأردن، حال الموظفين الفلسطينيين الذين يكنسون ويرتبون وينقلون و... بـملابسهم الرثة، ورؤوسهم المحنية، وخطواتهم المتثاقلة، يتكلم بعضهم العبرية بما تيسر له من التجربة، والعلاقة بينه والجنود الذين ينادونه لإنجاز مهمة ما، حتى أنني لم أميز فلسطينيّة أحدهم لطلاقته العبرية مع يهودية خرجت كي "تتشمّس" ربما، بعيدًا عن المكيفات التي تحميها من "السبع درجات الأعلى من معدلها السنوي في نيسان".
في اللحظة التي ركبت الباص الذي سيأخذني إلى الجانب الأردني، كانت حارتنا الصغيرة تخترق البال، وأفكر، بأن كل هذه الترتيبات والمشاعر والحشود الذاهبة والقادمة، لو سلطنا عليها كاميرا من أعلى، سنجدها بحجم حارتنا، ولا أظلم الأخيرة في التشبيه، إنما في المساحة الوهمية.
إلى فلسطين
درجة الحرارة مرتفعة. الحوقلة والتأويلات لدواعي توقيف الباص الذي أقلّني وأختي وابنتها (عام و4 أشهر) تنتقل من راكب لآخر، والشوكولاتة التي أهداها جدّان جميلان لابنة أختي، لا توقف بكاءها المتواصل. كيف أوضح لأيّان سبب هذا التوقيف؟ كيف أتخلص من دموعها التي تنخر عقل أمها لدرجة تهدئتها بالصراخ من ثم احتضانها؟ كيف؟
خطوة خطوة، ها نحن نمر، "نعتل" حقائبنا وننتظر في الصف، وأنا لا أسمح لأحد أن يتجاوزني، ثم بعد نحو نصف ساعة دخلنا، ومسيرة جديدة بين قضبان الحديد، كم كان مؤذيًا منظرها ونحن محاصرون فيها –أظنهم ابتكروها للحفاظ على صف منتظم- ألهذه الدرجة نحن فوضويون كي يتم ترتيبنا بالحديد؟
أتعرف فيلم "تيمبل جراندن"، الدكتورة الأمريكية التي تغلبت على مرض التوحد، وكان أحد ابتكارتها طريقا تمشي فيه الأبقار بشكل سلس ومنظم كي لا ترتعب قبل دخولها للمسلخ؟ هذا ما تذكرته حين سلكت بين ذاك الحديد، أتظن فكرة أسوأ من هذه؟
في هذا الحصار فرصة لنظرات وتساؤلات صامتة بين الوافدين إلى الوطن، وبين من يعرفون بعضهم أحاديث طويلة، وتجاوزات للبعض من خلال التسلل من ممر لآخر أسفل القضبان الحديدية، وفرصة لقراءة كل اللافتات التي تعلو رؤوس الجنود الواقفين خلف كاميراتهم وحواسيبهم التي تكشف مضامين الحقائب.
لكثرة ما قرأت ورنّت الآلة اللعينة، بدأت أتفقد المعادن على جسدي، ولم أجد أكثر من سلسلة فضة وسوار من صديقة تونسية، خبأتهما في قلبي وانتظرت، وإذ بشاب أمامي يقول لي ساخرًا "لسا مطوّل دورنا"، كان يبدو من حديثه مع مرافقه أنه يأتي فلسطين للمرة الأولى.
الوافد في مواجهة الآلة، يهلل ويكبر في أعماقه، ويخلع نعلًا تلو حزام تلو ساعة أو مصاغ، ويشعر بالحرّ والذل في آن، والصهيونية تقف خلف النافذة لا تفقه سوى أمر واحد بالعربية تردده "ارجع لورا"، ويرجع الفلسطيني، حتى يتناغم جسده والآلة التي تمارس سلطتها في كشف المعادن، وتعرّيه عبر "زامور خطرهها".
وهذا العكّاز الذي تم تمريره من موظف فلسطيني، عبر آلة أخرى، ينتمي ليد عجوز اقتيد إلى غرفة أسدلت عليها ستائر، ورأيت منها الأول يخلع ساعة وأشياء أخر يضعها في علبة لتمرّ قبله، مع العكّاز، وامرأة -ربما في السبعين- تنتظر الحل على كرسيها المتحرك لتمر عبر "الآلة".. وأنا أنتظر الدور!
خرج الفلسطينيون من حصار الحديد وآلات الكشف عن الغرائب والعجائب في حقائبهم وجيوبهم، واحتشد الكثير منهم أمام شبه بقالة، تبيع المشروب والمطعوم المختومين بلغة العدو، ما رأيك؟ تحدث.. لم أنت صامت؟!
وفعلًا، "طوّل دورنا"، ومكثنا أكثر من ساعة ونصف، القسم الأخير منها بعد احتجاز جواز السفر ومنعي المغادرة، مع فتاة أخرى وذات الشاب "الساخر"، فاستعنت بالفتاة لعلها تجد تأويلًا لاختيارنا من بين الجميع، فقالت بلغة الواثقة "همي بخافوا من العزابيات"... هههههه فقط تنتابني، ولا أظهرها، ألم يحص الصهاينة بعد عدد المتزوجات بين الأسيرات والاستشهاديات؟
إلى جانب الحقائب تنتظرني أختي مع ابنتها، بوجه غاضب، لأنني رفضت الدخول معها حين سمحوا لها ألا تنتظر بسبب بكاء ابنتها، لكن لو مررت سريعًا كيف سأغذي كرهي للاحتلال؟؟ أفكر وأحاول "ترقيع" موقفي بالجهاد في حمل الحقائب.
المحطة الأخيرة لدى الجنود، رجل وابنتاه يتجاوزانني للتحقق من وثائقهم، ولا شيء أفعله سوى التمتمة بصوت مرتفع، لا يعيرونه اهتمامًا ولا يخجلهم.
ليت الأمر توقف عند ذلك. كان حفيده يمسك بعملة معدنية ويصرخ كي توقفه أمه خلف الزجاج أمام الجندي الإسرائيلي، فأوقفت صراخه، وبدأ الطفل بالنداء "عمو.. عمو.." والأم تضحك، وبركان يغلي في دمي، وشتائم نابية أفكر فيها ولا أستطيع نطقها، وتقول له "ما تزعج عمّو".. يا إلهي، قبل دقائق فقط كنا نتأوه بين القضبان، ويضيع عمرنا في انتظار رحمة الآلة التي تكشف ما يخيفهم، هل أكثر قذارة من ذلك يا صديقي؟