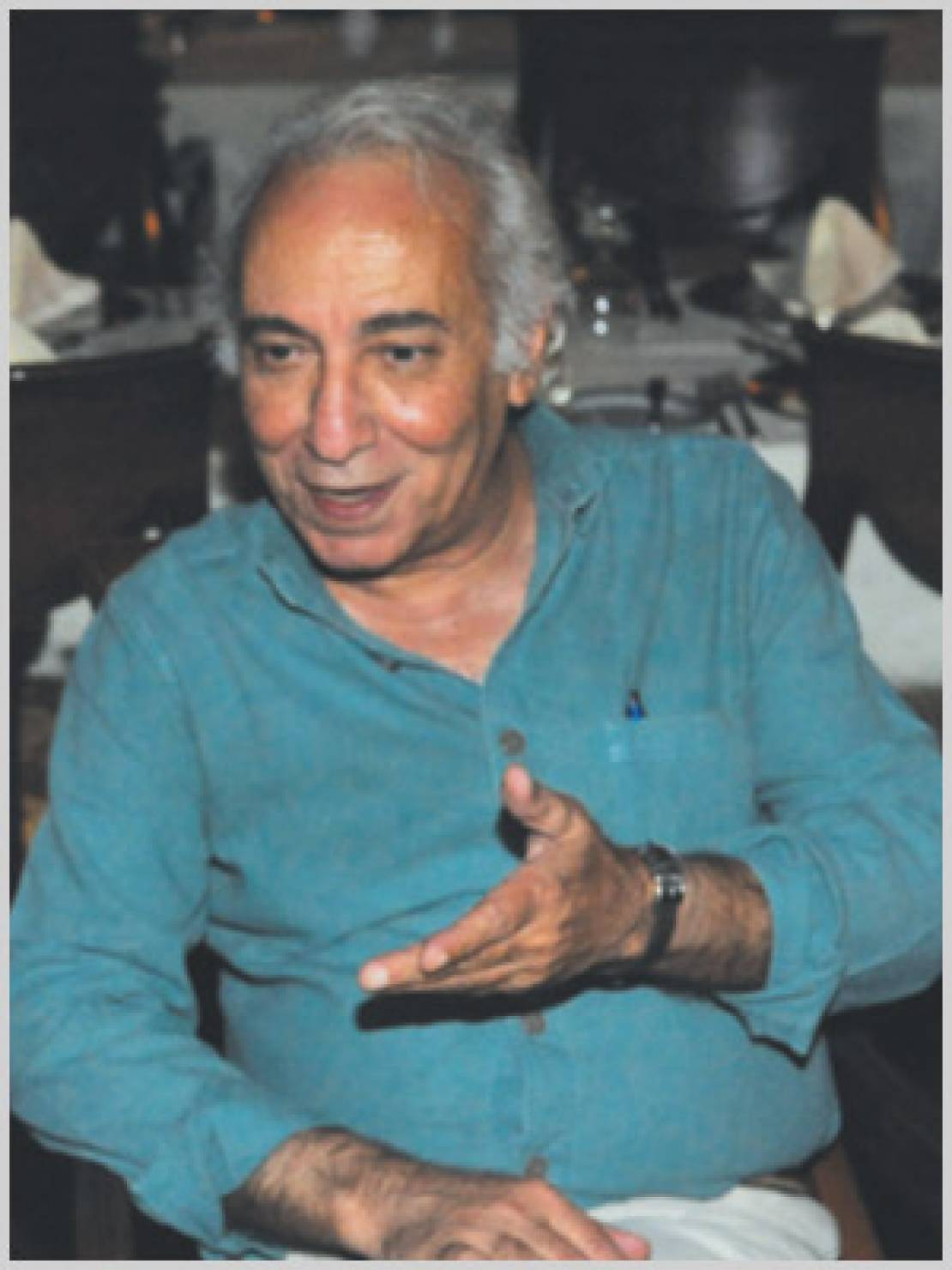محمد الأسعد
عُرف بعض الشعراء في تراثنا بالقصيدة الواحدة أو حتى البيت والبيتين. هذا تقليد قديم درجت العادة على نسبته إما إلى إن فلاناً شاعرٌ مقل أو إلى إنه لم يمتدّ به العمر ليقول غير ما وصلنا. وإذا تطرفت هذه العادة وصلتْ إلى إن ما قاله الشاعرُ كان من أجود ما قال.
ولكن حتى في هذا النطاق، وحين يقع الاختيار على قصيدة أو بضعة أبيات، ينتقي الناس، بتأثير ناقد أو خبير، شيئا لا يتجاوز البيت، ويقال إنه "بيت القصيد". ولفت نظري إن هذه المقولة الأخيرة توقفت عند هذه العتبة ولم تتجاوزها إلى رفع بيت القصيد المحتفى به إلى مرتبة القصيدة الكاملة. والشعراء من جانبهم لم ينتبهوا إلى إن بيت القصيد هذا يعني إنه القصيدة ذاتها، وما عداها إما حشو أو زيادات لا قيمة لها. معنى هذا إن فكرة البيت الواحد لم تتطور لدينا، ولم تستقل لتكون قصيدة كاملة بحد ذاتها. أي لم يجرؤ أحدهم على ممارستها بوصفها كذلك.
وحتى الآن لم يلتفت أحد إلى حقيقة إن غالبيتنا لا تتذكر قصيدة كاملة في معرض الاستشهاد أو التمثل بعاطفة أو فكرة أو صورة، بل تتذكر البيت أو البيتين. ولا تخيل أحد إن بيت القصيد يمكن أن يكون المقصود به إنه كل الشعر في هذه القصيدة أو القطعة وما يسبقه أو يليه فضول قول يمكن الاستغناء عنه.
في الشعر الياباني تجربة مشابهة تسمى "قصيدة الحلقات"، وهي قصيدة يشترك في نسجها عدد من الشعراء قد يبلغ عديدهم المائة أو أكثر. تبدأ هذه القصيدة بمطلع يقوله شاعر ذو مكانة معترف بها بين جمع، وتتبعه حلقات حين يضيف كل شاعر من المشاركين حلقة جديدة. وبمرور الأيام والسنين، استقل المطلع المسمى "هوكو" في القرن السادس عشر الميلادي، وصار يكتب مستقلا كقصيدة مكتملة، إلى إن وصل الحال بهذا الذي كان مطلعاً إلى أن يسمى "هايكو" في القرن التاسع عشر، وأعيد تقييم تراثه فشملته هذه التسمية الأخيرة بأثر رجعي.
واليوم يمعن هذا المطلع في استقلاليته، وقد انفصل تماماً، من حيث الإيقاع والقصد والتصوير وتمام التعبير عن الجسد الذي كان مجرد مطلع له.
لم يحدث هذا في القصيدة العربية التي نعرفها، وشرطها التقليدي أن تكون من سبعة أبيات، وظل بيت القصيد في مكانه. وتابعت القصيدة الحديثة (قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر) التقليد نفسه بعد أن سقط منها حتى بيت القصيد، بل ونافست القصيدة التقليدية في الامتداد والحشو والاستطالة حتى بدأ بعض أصحابها يحاول إعادتها إلى عصر القصيدة الملحمية والمسرحية.
ولم يحدث إلا في السنوات الأخيرة أن بدأ بعض المحدثين، تحت تأثير الهايكو اليابانية الواردة مع الرياح الغربية لا الشرقية، محاولة الاستقلال بالبيت والبيتين، ومعاملتهما معاملة القصيدة المكتملة، في وسط متلقين غير مقتنعين بما يتلقون، أو مشككين في جدوى تجربة من هذا النوع.
* * *
لماذا ولدت هذه "القصيدة" المكثفة؟ وقبل ذلك لماذا كانت الإشارة إلى "بيت القصيد" والاحتفاء به؟ هل كانت، شأنها شأن مطلع قصيدة الحلقات اليابانية، لمعة شعرية مضمرة وكامنة في القصيدة التقليدية، وجاء أخيراً من يمتلك الجرأة على قولها والاستقلال بها غير مبال بالمشككين أسرى التقليد والمطولات؟
جوابي؛ نعم .. كانت هذه هي القصيدة على وجه الحقيقة، ولم تكن المطولات إلا محاولات لتوسيع اللمعة والنبضة الحيوية الأولى التي تتبادر إلى مخيلة الشاعر للوهلة الأولى، ثم يرققها أو يمددها ويطيل ويذهب بنا هنا أو هناك تحت تأثير تقليد طويل الأمد؛ إن القصيدة التي تستحق هذا الاسم لابد أن تكون سبعة أبيات في الحد الأدنى وليس لها حد أعلى مهما أطال شاعرها. ويضغط المتلقي من جانبه ويطالب الشاعر بالمزيد بغض النظر عما إذا لم تكن هناك حاجة لزيادة مستزيد. وبغض النظر عن واقعة إن مفهوم القصيدة نفسه تطور، ولم تعد قصة أو جريدة تحتوي على أبواب متنوعة.
منذ وقت قريب استشهدتُ بـ "قصيدة" قالتها امرأة فلسطينية لاجئة مسنة حين مرت على ساحل البحر بمشهد شجرة دفلى برية تفتحت أزهارها الحمراء، فسمعتها تهتف كأنما تشهق الكلمات:
دفــلى..!
يا خسارة
راح العمر معمسة!
فكان رد فعل من سمعها، ليتها أكملتها!
ولمن لا يعرف معنى "معمسة"، نقول إنها اشتقاق من فعل "معس"، ومعس الشيء يمعسه معساً دلكه دلكاً شديداً. فكيف أيقظ مشهد أزهار الدفلى الحمراء إحساسا بالخسارة، وخسارة العمر الذي مضى تحديداً، ومضى مسحوقاً كما يسحق الأديم وغيره؟ وكيف يبعث مشهد إزهار عاطفة محرقة مثل هذه؟
من المؤكد إن هذه اللاجئة لم يمر في ذاكرتها مطلع قصيدة الانكليزي ت.س. إليوت الأرض اليباب:
نيسانُ هو الأقسى بين الشهور، يولّدُ
الليلكَ من الأرض الموات، يمزج
الذكرى بالرغبة، يستثيرُ
خامل الجذور بمطر الربيع
ولم تكن تعي إنها تقول شعراً. كل ما في الأمر إن شجرة الدفلى، التي ألفتها في بلادها شابة في ربيع عمرها، فاجأتها مزهرة، هي التي بلغت من العمر ما بلغت، وضاع من عمرها ما ضاع في بلاد الغربة، فأي هزة في الروح ستكون أبلغ من هذه الهزة؟
* * *
هذا هو باختصار بيت القصيد؛ نبضة روح ولمعة مفاجئة تحت تأثير مشهد جمع بين طرفين في دراما حياتية؛ بين سنوات تبعثرت وسحقت وربيع عمر أيقظته فجأة شجرة دفلى مزهر، وتخللهما أسفٌ وشعور بالخسارة المرة.
هل يحتاج كل هذا إلى تتمة، إلى إضافة؟ أم إن علينا أن نشتق من هذا الحديث معنى للشعر يغيب في خضم تقليد لم يعد له حامل من تجربة معاصرة أو مسار يبرره؟
في الأيام البعيدة صادفت شيئاً من هذا المفهوم أو حوله لدى الشاعر الفرنسي "بول فاليري" الراقد الآن في مقبرة مدينته المطلة على البحر. تحدث هذا الشاعر عن اللمعة الشعرية، وأطلق عليها تسمية القطعة الأرجوانية التي يقع عليها الشاعر ثم يواصل توسيعها والإضافة إليها. كان مقتنعاً إن النسيج يبدأ من هذه الجوهرة، وبهذا جعل القصيدة استطالة وتمدداً، لا ليتنكر للتطويل والامتداد بل ليذكّر بأن كل ما يضيفه الشاعر يجب أن يكون من جنس هذه اللمعة، هذه الماسة التي تشع من دون حاجة إلى شيء خارجها.
في هذا السياق نفسه تقع تلك القصيدة اليابانية المدهشة، فهي تسمى أيضاً جوهرة الشعر الياباني، ويرى فيها عدد متزايد من النقاد تجسيداً لاجتماع عاطفة وصورة في لحظة واحدة لا زمنية أي لا تعاقب فيها.
قيل مرة إن من علامات القدرة الإبداعية عند فنان ما معرفته أين يتوقف، وقيل أيضا إن التكثيف والاختزال والعودة بالعاطفة والفكرة والصورة، بل وحتى النغمة، إلى الأبسط هو معنى الفن قبل أن تأخذ الشاعرَ والرسامَ والكاتبَ والموسيقي من نفوسهم مطامعُ ومطامحُ تضعهم في خدمة أصحاب النفوذ والثراء. وأذكر حدثاً ذا معنى: حين شاهد الإيطالي "جياكومتي" تمثالا صنعه "بيكاسو" في مرسمه، وقف أمامه، فأزال منفضة الريش التي تمثل الرأس، ونقر بإصبعه على بطنه المكون من إناء خزفي ورماه جانباً قائلا " تمثالك جائع"، وظل يزيل قطعة قطعة إلى أن لم يبق سوى العمود المعدني، حامل التمثال، فقال له:
" الآن اكتمل تمثالك"!