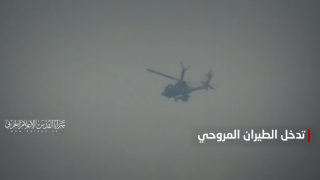يصعب تجاهل أوجه الشبه الصادمة بين المشاهد الأخيرة من توحش الشرطة داخل المدن في مختلف أرجاء الولايات المتحدة وعقود من العنف الذي ما فتئت تمارسه قوات الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وكانت الاحتجاجات الجماهيرية قد اندلعت على مدى أسبوعين في مختلف أنحاء الولايات المتحدة بل وحتى في أماكن كثيرة من العالم، بعد أن انتشر مقطع فيديو كانتشار النار في الهشيم لضابط الشرطة في مينابوليس، ديريك تشوفين، وهو يزهق روح رجل أسود، هو جورج فلويد، من خلال الضغط بركبته على رقبته لما يقرب من تسع دقائق.
كان ذلك المقطع أحدث دليل مرئي مزعج لما يسود أوساط الشرطة الأمريكية من ثقافة، بدا واضحا أنها تنظر إلى الأمريكيين السود على أنهم أعداء، وكان في الوقت نفسه مذكرا بأن ضباط الشرطة المارقين يندر أن يتعرضوا للعقاب.
يذكر مشهد مصرع فلويد على يد تشوفين، بينما كان ثلاثة آخرون من زملائه الضباط يتفرجون على عملية القتل أو يشاركون فيها، بمشاهد مزعجة باتت مألوفة داخل المناطق الفلسطينية المحتلة. فلطالما انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لجنود وشرطة أو لمستوطنين مسلحين إسرائيليين، وهو يطلقون النار على رجال ونساء وأطفال الفلسطينيين، أو وهم يؤذونهم ويسومونهم العذاب.
لطالما كان ذلك النمط من التعامل الوحشي واللاإنساني الذي أفضى إلى ارتكاب جريمة القتل بحق فلويد، مشهدا يتكرر بانتظام داخل المناطق الفلسطينية المحتلة، وخاصة منذ مطلع عام 2018، حينما بدأ القناصة الإسرائيليون يستخدمون الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال والمسعفين والصحفيين والمعوقين، كما لو كانوا أهدافا للتدريب على الرماية في أثناء الاحتجاجات الأسبوعية، على مقربة من السياج الذي ضربه الإسرائيليون حول قطاع غزة وحولوا من خلاله الفلسطينيين إلى مساجين.
الإفلات من المساءلة والعقاب
وتماما كما يحصل في الولايات المتحدة، يندر أن ينجم عن لجوء الجنود الإسرائيليين إلى ممارسة العنف ضد الفلسطينيين تحويل أي من هؤلاء الجنود إلى المحاكمة ناهيك عن إدانتهم.
بعد أيام قليلة من مقتل فلويد، أطلقت الشرطة الإسرائيلية في القدس النار على رجل فلسطيني اسمه إياد الحلاق يعاني من التوحد، وتقول عائلته إن مستواه العقلي لا يتجاوز عقل طفل في السادسة من عمره. ومع ذلك، لم يتم إلقاء القبض على أي من أفراد الشرطة المعنيين.
في مواجهة الإحراج الذي سببه له الاهتمام الدولي في أجواء ما بعد جريمة قتل فلويد، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحا نادرا، قلما يصدر عمن هو في منصبه إزاء قيام أجهزة الأمن بقتل شخص فلسطيني، حيث وصف نتنياهو جريمة قتل الحلاق بأنها "مأساة" متعهدا بإجراء تحقيق في الأمر.
وقعت جريمتا القتل على بعد أيام قليلة بعضهما عن بعض، وكأنما جاءتا لتؤكدا الانسجام الطبيعي بين شعاري "حياة السود تهم" و "حياة الفلسطينيين تهم"، سواء في الاحتجاجات أو في تدوينات النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
بالطبع، ثمة فروق بين الحالتين. فالأمريكيون السود الآن مواطنون يحملون جنسية أمريكا، ومعظمهم بإمكانهم المشاركة في التصويت في أثناء الانتخابات (إذا ما تمكنوا من الوصول إلى مراكز الاقتراع)، والقوانين لم تعد صريحة في عنصريتها، وبإمكانهم التقاضي أمام المحاكم نفسها، ولئن لم يحظوا دائما بالعدالة نفسها، مثلهم في ذلك مثل السكان البيض.
الوضع ليس كذلك بالنسبة للفلسطينيين الجاثمين تحت الحكم الإسرائيلي. فهم يعيشون في ظل احتلال جيش أجنبي، وتحكم حياتهم أوامر عسكرية تعسفية، ولا يحظون سوى بقدر محدود جدا من إمكانية اللجوء إلى أي إجراءات قانونية ذات معنى.
وهناك فرق واضح آخر، فقد صدمت جريمة قتل فلويد كثيرا من الأمريكيين البيض فخرجوا وانضموا إلى الاحتجاجات. بالمقابل، لقيت جريمة قتل الحلاق تجاهلا من الغالبية العظمى من الإسرائيليين، حيث تم قبولها فيما يبدو كثمن لا بد منه للإبقاء على الاحتلال.
أن تعامل كعدو
ومع ذلك، تستحق المقارنات بين الثقافتين الشرطيتين العنصريتين تسليط الضوء عليهما؛ فكلاهما تنبعان من رؤية للكون شكلتها مجتمعات استيطانية استعمارية تأسست على نزع الملكية، والفصل، والاستغلال.
ماتزال إسرائيل، إلى حد كبير، تعامل الفلسطينيين كأعداء تحتاج إما لأن تطردهم أو تفرض عليهم الخضوع لها، بينما يعيش الأمريكيون السود مع إرث الثقافة العنصرية البيضاء، التي ظلت حتى وقت ليس بالبعيد تبرر الرق والأبارتيد (الفصل العنصري).
تعرض الفلسطينيون والأمريكيون السود منذ وقت طويل للسطو على كرامتهم، ولطالما اعتبرت حياتهم زهيدة.
من المحزن أن يعيش معظم اليهود الإسرائيليين في حالة من الإنكار العميق بشأن الأيديولوجيا التي قامت عليها مؤسساتهم الرئيسية، بما في ذلك الأجهزة الأمنية. قلة قليلة جدا منهم يتظاهرون تضامنا مع الفلسطينيين، ومن يقدمون على ذلك يعتبرهم بقية الجمهور الإسرائيلي خائنين.
في المقابل، صعق عدد كبير من الأمريكيين البيض حينما رأوا كيف سارعت قوات الشرطة الأمريكية، حين ووجهت باحتجاجات واسعة النطاق، إلى استخدام أساليب عدوانية للتحكم بالجمهور، شديدة الشبه بتلك الأساليب التي باتت مألوفة جدا لدى الفلسطينيين.
تشتمل هذه الأساليب على إعلان حظر التجول وإغلاق الأحياء داخل المدن الكبيرة، ونشر فرق القناصة ضد المدنيين، واستخدام فرق لمكافحة الشغب لا ترتدي زيا رسميا ولا أقنعة، واعتقال الصحفيين والاعتداء عليهم بالضرب رغم أنه يمكن التعرف عليهم بوضوح، والاستخدام العشوائي للغاز المسيل للدموع وللذخيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، لإصابة المتظاهرين وترهيبهم حتى يخلوا الشوارع.
ولا ينتهي الأمر هنا
لقد نعت الرئيس دونالد ترامب المتظاهرين بالإرهابيين، فكان ما قاله صدى للتصنيف الذي يطلقه الإسرائيليون على الاحتجاجات الفلسطينية، بل وهدد بنشر الجيش الأمريكي، الأمر الذي يمكن أن يشكل نسخة طبق الأصل عن الوضع الذي يواجهه الفلسطينيون.
وكما يفعل الفلسطينيون، ذهب أبناء المجتمع الأسود في الولايات المتحدة، وانضم إليهم الآن معشر المحتجين، يسجلون باستخدام هواتفهم نماذج من الإساءات التي يتعرضون لها ثم ينشرونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتسليط الضوء على أضاليل ما يصدر عن الشرطة من تصريحات، وما تنشره وسائل الإعلام بخصوص ذلك الذي يجري في أرض الواقع.
تم تجريبه على الفلسطينيين
لا ينبغي أن تفاجئنا أي من هذه الممارسات المتشابهة، فمنذ سنوات وقوات الشرطة الأمريكية، كما هو حال الكثير من قوى الشرطة حول العالم، تصطف في طابور على باب إسرائيل لكي تتعلم من تجربتها في سحق المقاومة الفلسطينية طوال عقود من الزمن.
لقد استغلت إسرائيل الحاجة لدى الدول الغربية، في عالم تستنزف فيه الموارد وينكمش فيه الاقتصاد العالمي على المدى البعيد، للتهيؤ لمواجهة انتفاضات شعبية داخلية تشعل شرارتها في المستقبل الطبقات الدنيا من المجتمع.
بوجود مختبرات جاهزة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، تمكنت إسرائيل منذ زمن طويل من تطوير أساليب جديدة للمراقبة والإخضاع وتجريبها ميدانيا على الفلسطينيين الأسرى لديها. وبحكم أنها أكبر طبقة دنيا داخل الولايات المتحدة، كانت مجتمعات السود داخل المدن الأمريكية مهيأة باستمرار لأن تجد نفسها يوما ما على خطوط المواجهة، بينما تلجأ قوات الشرطة الأمريكية إلى مقاربة أكثر عسكرية في الحفاظ على الأمن والنظام.
بدأ الناس يشعرون بهذه المتغيرات في أثناء الاحتجاجات التي انطلقت في فيرغسون بولاية ميسوري في عام 2014، بعد أن قتلت الشرطة رجلا أسود اسمه مايكل براون. انتشر أفراد قوات الشرطة المحلية وهم يرتدون الملابس العسكرية ويستخدمون الدروع تسندهم عربات الجنود المصفحة، فكانوا أشبه بمن يدخل ساحة الحرب، وأبعد ما يكونون عمن جاء بهدف "الخدمة والحماية".
التدريب في "إسرائيل"
حينها بدأت جماعات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات تسلط الضوء على مدى تأثر قوات الشرطة الأمريكية بالأساليب الإسرائيلية في إخضاع الفلسطينيين، وتبين أن كثيرا من أفراد هذه القوات تلقوا تدريباتهم في إسرائيل أو شاركوا في برامج التبادل.
لقد غدت شرطة الحدود الإسرائيلية سيئة الصيت، بشكل خاص، نموذجا يحتذى في البلدان الأخرى. وشرطة الحدود تلك هي التي أطلقت النار على الحلاق وأردته قتيلا في القدس، بعد وقت قصير من مقتل فلويد على أيدي الشرطة في مينابوليس.
تقوم شرطة الحدود بوظائف هجينة مستمدة من مهام الشرطة ومن مهام الجيش، وتعمل ضد الفلسطينيين في المناطق المحتلة وداخل إسرائيل، حيث تعيش أقلية فلسطينية كبيرة بحقوق مواطنة مختزلة جدا.
والأساس الذي تنطلق منه شرطة الحدود، هو اعتبار جميع الفلسطينيين، بما في ذلك من يعتبرون رسميا مواطنين إسرائيليين، أعداء ووجوب التعامل معهم على أنهم كذلك. وذلك يقع في الصميم من ثقافة شرطية إسرائيلية عنصرية، تم الكشف عنها قبل سبعة عشر عاما في تقرير "أور"، الذي كان التقرير الجاد الوحيد الذي أعد في البلاد حول قوات الشرطة.
أصبحت شرطة الحدود الإسرائيلية هي النموذج الذي تقلده قوات الشرطة الأمريكية الآن في المدن التي تعيش فيها أعداد كبيرة من السود.
وكان العشرات من ضباط شرطة مينابوليس قد تلقوا تدريبات على أيدي خبراء إسرائيليين في مجال "مكافحة الإرهاب" ووسائل "الضبط والإخضاع"، في مؤتمر تم تنظيمه في شيكاغو في عام 2012.
عندما استخدم ديريك تشوفين ركبته للضغط على رقبة فلويد، كان يطبق إجراء شل الحركة الذي يعرفه الفلسطينيون جيدا. والمزعج في الأمر، أن تشوفين كان في لحظة قتله لفلويد يدرب ضابطين مستجدين، وينقل إلى الجيل الجديد من الضباط المعرفة التي تتوفر لدى مؤسسة الشرطة التي يعمل فيها.
احتكار العنف
ينبغي توقع أوجه الشبه تلك، فالدول لا محالة تستعير وتتعلم بعضها من بعض في القضايا الأهم بالنسبة لها، مثل قمع أي تمرد داخلي. فمهمة الدولة هي ضمان أن تظل محتكرة لممارسة العنف داخل حدودها.
ومن أجل ذلك، حذر العالم الإسرائيلي جيف هالبر قبل عدة سنوات في كتابه "حرب ضد الشعب" من أن إسرائيل تؤدي دورا مفصليا فيما سماه صناعة "التهدئة والتسكين العالمية". لقد انهارت الجدر الصلبة التي كانت قائمة بين الجيش والشرطة، مما أوجد ما سماه "الشرطة المحاربة".
يكمن الخطر، بحسب ما يراه هالبر، في أننا على المدى البعيد، وكلما زادت عسكرة الشرطة، من المحتمل أن نجد أنفسنا نعامل مثل الفلسطينيين. ولهذا ثمة حاجة إلى تسليط الضوء على مزيد من المقارنة بين الاستراتيجية الأمريكية تجاه مجتمع السود واستراتيجية إسرائيل تجاه الفلسطينيين.
فالبلدان لا يتشاركان فقط في التكتيكات والوسائل الشرطية التي تستخدم ضد الاحتجاجات بمجرد اندلاعها، بل لقد قاما بشكل مشترك بتطوير استراتيجيات طويلة المدى على أمل تفكيك قدرة مجتمعات السود والفلسطينيين، التي يضطهدونها، على التنظيم بشكل فعال وعلى التضامن مع المجموعات الأخرى.
ضياع التوجه التاريخي
إذا كان ثمة درس واضح، فهو أن الاضطهاد يمكن أن يتم تحديه على أفضل وجه من خلال المقاومة المنظمة التي تمارسها حركة جماهيرية، لديها مطالب واضحة ورؤية محكمة لمستقبل أفضل.
كان ذلك يعتمد في الماضي على زعامات من أصحاب الكاريزما، ينطلقون من أيديولوجيات يعبرون عنها بشكل جيد ولديهم القدرة على إلهام واستنفار الأتباع. كما كان يعتمد على شبكات من التضامن بين المجموعات المضطهدة حول العالم، التي تتبادل فيما بينها خلاصة ما لديها من معارف وتجارب.
كان الفلسطينيون ذات يوم تقودهم شخصيات تتمتع بدعم واحترام وطني من ياسر عرفات إلى جورج حبش إلى الشيخ أحمد ياسين. وكان النضال الذي تزعموه قادرا على إلهاب مشاعر الأنصار حول العالم.
لم يكن أولئك الزعماء متحدين بالضرورة، وكان هناك جدل حول ما إذا كان الأفضل التصدي للاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي من خلال النضال العلماني أو من خلال الثبات الديني، ومن خلال إيجاد حلفاء في أوساط الأمم المضطهدة، أو إلحاق الهزيمة به باللجوء إلى وسائل ذاتية عنيفة.
ساهم ذلك الجدل وتلك الاختلافات في تثقيف الجمهور الفلسطيني العام، موضحة لهم المخاطر، وكانت تمنح إحساسا بوجود توجه تاريخي وغاية ما. وغدا هؤلاء القادة رموزا للتضامن الدولي وللحماس الثوري.
إلا أن كل ذلك عفا عليه الزمن، حيث انتهجت إسرائيل سياسة لا هوادة فيها، شملت سجن القيادات الفلسطينية واغتيالها. وفي حالة عرفات، تم حصاره داخل المقاطعة في رام الله حيث أحاطت به الدبابات الإسرائيلية من كل اتجاه، وقتل في نهاية المطاف مسموما في ظروف مريبة. منذ ذلك الحين والمجتمع الفلسطيني يشعر باليتم وبالتيه ويعاني من الانقسام ومن الفوضى.
كما تم تهميش التضامن الدولي أيضا. وبدت الجماهير العربية، التي انشغلت بقضاياها ونضالاتها، وكأنما سئمت من الانقسام والبؤس الذي تشهده القضية الفلسطينية. وفي هذه الأثناء، تحولت حركة التضامن الدولي إلى حركة مقاطعة تخوض قتالا داخل أرض العدو، وهي أرض تقوم على الاستهلاك والمال.
من المواجهة إلى الصبر
مر مجتمع السود في الولايات المتحدة بعمليات مشابهة، حتى وإن كان يصعب توجيه إصبع الاتهام إلى أجهزة الأمن الأمريكية بخصوص ما جرى قبل عقود من تصفية قيادة حركة السود. من المعروف أن أجهزة الأمن الأمريكية كانت تلاحق مارتن لوثر كينغ ومالكولم إكس وحركة النمور السود، ورغم ما كان بينهم من تباين في النضال من أجل الحقوق المدنية، إلا أنهم جميعا تعرضوا للسجن أو الاغتيال.
واليوم، لم يعد يوجد منهم أحد ممن يملك القدرة على إلقاء الخطب الملهمة وعلى استنفار الجمهور العام – سواء في أوساط السود أو البيض من الأمريكيين – للقيام بعمل ما على المستوى الوطني.
وبحرمانه من الزعامة الوطنية القوية، بدا مجتمع السود المنظم في بعض الأوقات منكفئا نحو حيز أكثر أمنا، وإن كان أكثر تقييدا، داخل الكنائس، على الأقل إلى أن اندلعت الاحتجاجات الأخيرة. يبدو أن سياسة الصبر والسلوان حلت مكان سياسة المواجهة.
التركيز على الهوية
لا يمكن نسب هذه التغيرات فقط إلى فقدان الزعامات الوطنية، بل لقد طرأ في السنوات الأخيرة تحول أيضا على سياق السياسة العالمية؛ فبعد انهيار الاتحاد السوفياتي قبل ثلاثين عاما، لم تصبح الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة في العالم فحسب، بل سحقت الحيز المادي والأيديولوجي الذي كانت تزدهر فيه المعارضة السياسية.
وتم جراء ذلك إبعاد التحليل الطبقي والأيديولوجيات الثورية – سياسة العدل – من الشوارع لتوجد بشكل متزايد في هوامش العالم الأكاديمي.
بدلا من ذلك، شجع النشطاء السياسيون الغربيون على تسخير طاقاتهم ليس في مناهضة الإمبريالية والنضال الطبقي، وإنما لسياسات الهوية الأضيق نطاقاً. وغدت النسبية السياسية مجالا للتنافس بين المجموعات الاجتماعية للفوز بالاهتمام وكسب الامتيازات.
وكما هو الحال مع نشاط حركة التضامن مع الفلسطينيين، راحت سياسة الهوية في الولايات المتحدة تخوض معاركها داخل مجتمع مهووس بالاستهلاك. وصار الهاشتاغ يستخدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي للنيابة عن الاحتجاج والنشاط المجتمعي.
لحظة التحول
والسؤال الذي تطرحه الاحتجاجات الحالية في الولايات المتحدة، هو ما إذا كان هذا النمط من السياسة، وهو نمط خجول ومستفرد ومستكسب، غير كاف. فالمحتجون في الولايات المتحدة مازالوا بلا قيادة، يواجه نضالهم خطر التشظي، بينما مطالبهم ضمنية وبلا شكل واضح، وما لا يريده المحتجون أوضح مما يريدونه.
وذلك يعكس مزاجا حاليا تبدو فيه التحديات التي تواجهنا – من الأزمة الاقتصادية الدائمة والتهديد الجديد الذي يشكله الوباء إلى نكبة المناخ وشيكة الوقوع – كبيرة جدا، بل وأضخم بكثير مما يمكن للمرء أن يدركه. نقف عند لحظة تحول، كما يبدو، تنبئ ببدء مرحلة جديدة – جيدة أم سيئة –ليس بإمكاننا إدراك ذلك بوضوح بعد.
يتوقع أن يتوجه إلى واشنطن الملايين في شهر آب/أغسطس، في مسيرة تماثل تلك التي قادها مارتن لوثر كينغ في عام 1963. يتوقع أن يقع العبء الثقيل لهذه اللحظة التاريخية على كاهل القس المسن آل شاربتون.
قد تكون تلك الرمزية مناسبة. فقد مرت خمسون عاما منذ آخر مرة شهدت فيها الدول الغربية حماسة ثورية، إلا أن الجوع إلى التغيير الذي وصل ذروته في عام 1968 – رغبة في إنهاء الإمبريالية والحروب التي لا تنتهي وانعدام المساواة – لم يُشبع.
وماتزال المجتمعات المضطهدة حول العالم تتضور جوعا لعالم أكثر إنصافا. في فلسطين وفي غيرها، أولئك الذين يعانون من القسوة والبؤس والاستغلال والامتهان، مازالوا بحاجة إلى بطل. يتطلعون إلى مينابوليس والنضال الذي أشعلت شرارته بحثا عن بذرة أمل.
المصدر: (ميدل إيستآي) ترجمة "عربي21"