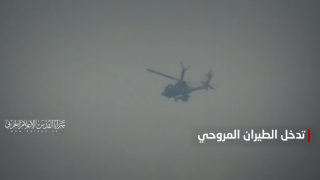"ألا ريت الزمن يرجع ورا وإلا الليالي تدور... لو يرجع ونسترجع طفولتنا" هي كلمات من أغنية "عيال حارتنا" التي غناها الفنان القدير علي بن محمد، شكلت في ذاكرتي نظماً جميلاً لما تنشأت عليه في نعومة أظفاري.
لكن الوقع جداً مؤلم على القلب كلما تأكدت أن العودة على ذي بدء غير جائزة، حيث أن الطفولة مرحلة انتهت، كما أن محاولات استذكارها موجعة للاجئ فلسطيني سوري مثلي صار به الحال مهجراً تحت ضربات الصواريخ وكشرات الأنياب، فلا يحق له الآن على أقل تقدير رؤية شواهد طفولته الشهيدة في بقايا مخيم اليرموك، والبقايا هنا حجارة، أماكن، أرواح وأهل محاصرون..
تلك الحواجز والمتاريس والسواتر تحجب النظر إلى ماوراء جامع البشير عند مدخل السجن الكبير المسمى زورا عاصمة شتات الفلسطينيين.. وإن نجحت عدسة العين ووثقت نظرة إلى الداخل، باغتتها رصاصات القناص الذي امتهن حرمان المبعدين من الأحلام وثقب خزانات القارعين للحياة في الداخل.
لنا أن نتخيل طاقة فتحت وأتاحت مرور خيط ضوئي يصل إلى حيث نصب جارنا أرجوحته في ساحة "أبو حشيش" قبيل صلاة العيد، أو أن تزور الخيوط أصداء أرواح تمشي في شوارع مدارس طفولتنا التي دمرتها آلة الحماة وصارت تسمى بديلة في زمن العراة، لتغلقها أيادي المستخلفين في أرض بوار.
أتذكر جيدا كيف اختبأت في قميص نوم جدتي، وانهمك أبي في البحث عني مبتغياً عقابي على إلقاء الكرة خاصتي على رأسه وهو نائم.. كنا حينها نسكن بيت جدي أبو ياسين أحد شواهد النكبة الأولى والراحل قبل أن يصاب بنكبة ثانية.
لا بأس يا جدي فالأبناء أصيبوا بنكبات متعددة.. وحياة الطفولة لا تنسى رغم ما ألمّ بالجميع.
ذات مساء، عاقبت تلفازاً يابانياً قديماً أحمر اللون رمادي الصور دفعت فيه العائلة الكثير... إنها فترة التسعينات العسيرة على معظم سكان سوريا.
كان قصيرَ العمر نائماً على الطاولة التي تلعب دور القفل في وجهي، فيما البرّاد الموصد عن استقبال الزبائن يناديني من ورائها... لم آبه لكل ذلك، وكان همي الوحيد وأنا ابن الخمسة شتاءات، أن أحظى بشرف الاستحواذ على كأس من عصير التوت الصناعي يبرّده عمي لتحضير مثلجات "أسكا بليرة" يبيعها في محل بقالته الصغير الواقع على أطراف المخيم.
عندها دخلت جدتي ووجدتني كما الصليب المعقوف، رأسٌ داخل طنجرة الشراب وقدمان فوق الطاولة، فيما سبقني التلفاز إلى حصيرة الغرفة، ليس تطبيقاُ منه لقانون الجاذبية الأرضية ، بل احتراماً لطفولتي..... نيوتن الذي اكتشف التفاحة كان عارياً، وعاش طفولته قبل أن يفكر مليّاً بالمجريات ولا يحق له بأي حال فرض شيء على تلفازي!، أنا وتلفازنا أحرار في حركاتنا!..
جدتي صفية تصرخ: "يا ابن الفجل!!"..... لم أعد حينها أدري بصراحة؛ هل "إم نبيل" تقصد التلفاز أم جارور البرّاد؟، فالفجل يجيء في برنامج "أرضنا الخضراء" الذي أحفظ أغنيته المملة إلى يومي هذا، كما يوضع في برادنا المخبول .. هي حتما لا تستهدفني بصراخها!!
هل خرج أحدكم إلى "قاع الديار" المكشوفة للسماء في بيت عربي بارد، أثناء هطول الأمطار الغزيرة شتاءً، حاملا معه المسّاحة، أو كما يقال لها باللكنة الشامية "القشّاطة"، وكل همّه تمشيط الأرض المبللة من مياه المطر المستمر بالهطول؟!... لا دوافع منطقية سوى الولدنات... نعم أنا فعلتها حين كان عمري ست سنوات، وواصلت جهودي لتجفيف قاع الديار حتى العاشرة، غير أني اقتنعت في الحادية عشرة أنه يتوجب على أبناء عمومتي الأصغر مني سنّا مساعدتي في العملية!!! فأنا عاجز عن المواصلة لوحدي...
صرت شيخا في الصف الرابع... لا عجب من ذلك فوالدتي تنجب أختي الرابعة وأنا مسرور من الله على نعمة الأخوّة فقررت التعبّد بعد العودة من دوامي المدرسي المسائي.. وتحولت إلى "أزعر" في الصف الخامس يحاول تقليد شباب الحارة ويجلس على "السوكة" ليرتدّ طفلا عند أذان المغرب حين تصيح به أمّه: "يالله ولاا تعال كول وانقبر دوامك بكرا الصبح"!!.. لا بأس فهي الحياة هكذا، تشبه مؤشر البورصة صعودا وهبوطا، فرح ينتهي بليفة الحمّام الخشنة وضحك يبدأ مع دمعات مخنوقة على بطني المجبور لتناول الملوخية الورق التي لم أكن أحبّ.
ما معنى أن تبكي عند غروب شمس آخر أيام عيدي الأضحى والفطر... وأن تفكر في أنّك مستعد لإمضاء ما تبقى من السنة لانتظار العيد القادم، معتبرا أن الاحتفاظ بألعاب العيد ووضعها على الفراش، هي الوسيلة الوحيدة لنسيان طول الفترة المتبقية.
كيف بكيت ظنا مني أن أمي وصديقتها يضحكان عليّ... لأكتشف بعد عشرين عاما على الأقل أنّ كبار السن يخفتون أصواتهم في الحديث ويرفعونها أثناء الضحك رغما عنهم... ربما هذا ليس صحيحا أيضا، لا أدري؛ فطفولتي زادت عن حدّها قليلا قبل أن تتوقف وأكمل المسير وحيدا.
البكائيات الأعظم تجيء على بقايا الكرة التي أغضبت والدي، فهذه المرّة علقت على سطح بيت جارنا في حارة السهليّة ونحن نلعب "نص غوول"... غابت الكرة عني ثلاثة أيام بلياليها أمضيتها غارقا بدموعي، لتردّ إلي الروح والضحكات مع قرع جرس بيت جدي: "هاي الطابة أشرف" ويالها من فرحة!...
أشتهي أكل البوظة المجمدة وإسالتها على مريولة المدرسة كي أجد عذرا لخلعها في الصفّ... وأتمنى أن أتناول كمية من الملح مع الكمّون وضعها الحاج أبو محمد العمايري للبيع "كل تنتين بليرة" في متجره قبالة مدرسة ترشيحا، قبل أن أبدأ المباراة اليومية التي تسبق الدوام بنصف ساعة في حارة آل التميم _من أبناء قرية الجاعونة الفلسطينية المهجرة_ أنا ومجموعة من رفاقي التلاميذ _لا أعلم شيئا عن مصيرهم بعد النكبة الثانية_ مستخدمين كرة هوائية لا يتجاوز سعرها 15 ليرة.
ولعل بعضا من كلٍّ حلوٍّ ومرٍّ، فشلت بالتصريح ضمنه عمّا اقتبست من حبّ وحرب عن بيئتنا الطيبة الخبيثة معاً.. فقدسية الطفولة تمنع مستذكريها قول جميع الأشياء دفعة واحدة.
كما أن جرد الحسابات في نهايات سنيّ الأمم تضع أياما عالمية للتضامن كلاميا مع بقايا مهاجر لطفولته القسرية، عجز الكثيرون إحقاق آدميته بطريقة تتناسب مع براءة وجوه صبية المخيم الوسيمين والصلبين جدا، أثناء خروجهم من تحت ركام اللجوء. فلماذا يريدون منهم قول كل شيء؟!.
هذا ليس كلّ شيء، فطفولة اليرموكيّ تحتاج جردات حساب طويلة في صفحات الذاكرة. ولعلّ النقش على الحجر، ليس حال العلم في الصغر كما يزعمون، بل حال أيام الولدنة كاملة بشتى تفاصيلها وبراءاتها، حتى وإن زارت الحرب أشلاءها، فهي تزرع نفسها في طين المخيم وتخرج منه متجذرة أعمق من ذي قبل وأشدّ طفولة..