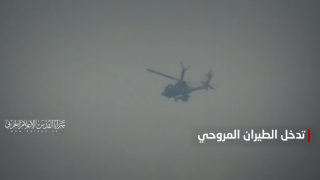كعادة الطلاب وقت خروجهم من الامتحان أن يراجعوا ما استقرت عليه إجاباتهم في ورقة الأسئلة، خرجت من بوابة مدرسة الكرمل أراجع مع زملائي بعضاً من الأسئلة، وكان أقصى ما يمكن ان تحمله كلمة "قنبلة" هو ان تجد اجابةً خاطئةً أو فهماً غير موفق للسؤال.
لكن وقع القنبلة، بل القنابل، كان ينتظر أن أصل إلى مفترق التشريعي لأصبح مطلاً على مدينة عرفات للشرطة –الجوازات- التي استقبلت الدفعة الأولى من صواريخ الاحتلال في السابع والعشرين من ديسمبر عام 2008.
مدرسة الكرمل قريبة كل القرب من مركز العباس للشرطة، ويتقدمها باتجاه الشرق مبنى المجلس التشريعي، وتقع على بعد مئات الأمتار منها الجوازات، كما يقع في دائرتها الأولى مستشفى الشفاء، لذا كانت الحيرة هي الشعور الذي تلا صدمة سماع الانفجارات وتصاعد دخان الصواريخ.
كنا ننظر باتجاه مدينة عرفات فإذا بها تقصف غارةً تلو غارة، التففنا لنهرب باتجاه المجلس التشريعي لنرى عناصر الشرطة يهربون من بوابة المجلس خوفاً من القصف، فنسبقهم هاربين باتجاه مركز شرطة العباس على غير وعيٍ منا ولا إدراك، ودوناً من وصول المركز فإذا به يقصف، هربنا شمالاً باتجاه مستشفى الشفاء، حينها أصابتني شظية تطايرت بفعل القصف، لم أدرك أنها أحدثت جرحاً طفيفاً في رأسي إلا بعد عدة أمتار.
نصحني أصدقائي أن أدخل المستشفى -بصفتي المصاب الوحيد بينهم-، وفعلت، كان جديداً علي أن أهرول والدم يسيل من رأسي، دخلت -بنفسية المصاب- لقسم الاستقبال بمستشفى الشفاء الذي بدت على الممرضين والأطباء فيه ملامح الارتباك.
ناولني ممرض شاشة لأضعها على موضع الدم، وطلب مني الجلوس على أحد الأسرة، دقيقتان حتى بدأ نزيف الجرحى يتدفق من باب القسم، تصاحبه جوقة من الصراخ والنحيب والتأوه، ثلاث دقائق وامتلأت الأسرة، نهضت وجلست على كرسي الممرض المناوب لأفسح المجال لمداوة من هم أحق مني باعتبار إصابتي طفيفة.
بعد خمسة دقائق كان علي أن انتقل للجلوس على مكتب الممرض لوصول أعدادٍ جديدة من المصابين، جلس بجواري شرطي فقد ذراعه، والدم ينبثق من كتفه، كان يردد: “يا الله” بصراخٍ تردد صداه على ألسنة من حولي، الذين اتخذوا من أرضية المشفى أسرةً لهم، حتى ما عاد في القسم موضع قدم.
أذكر جيداً كيف أن ممرضة أتت تصرخ في وجه زميليها الممرض: “يا دكتور يا دكتور شو نعمل؟”، ليصرخ هو الآخر في وجهها: “أنا ممرض زيي زيك.. شو بدي أعمل يعني؟”، نفدت في الدقائق الأولى الأدوات الأولية المستخدمة في تطهير الجروح والتعامل مع الإصابات، ربما كنت محظوظاً بأن حظيت بشاشة أضعها على رأسي لأضمد بها الجرح الصغير.
لم يكن علي الانتظار كثيراً حتى أدرك أنني في المكان الخطأ، ربما الرأس المنزوعة عن الجسد التي جاء يحملها أحد المصابين بشظايا متنوعةٍ في جسده، كانت كفيلة بتعميق شعور أني “باتدلع، وعامل حالي مصاب”.
قررت الخروج من القسم، فرائحة الموت التي عبقت المكان كانت كفيلة بأن تطمس أي محاولة للحياة حال البقاء بين هذه النوعية من الإصابات.
تنقلت هويناً هويناً مخافة أن أصدم قدماً مصابةً، أو يداً مبتورةً، توجست من تعثري بجسدٍ بلا رأس، أو الدوس على بركة دماءٍ امتزجت فيها دم الشهداء والمصابين معاً.
سبعة أمتار كانت بيني وبين باب الخروج، لكن الوصول إليه استغرق ما يزيد على عشرين دقيقة، وأكاد أجزم أنني ما كنت لأتمكن من الخروج لولا ذلك الشرطي الذي خرج من غرفة الجبس بعد أن وضع فيها أحد زملائه المصابين، وشرع يقرأ آياتٍ من القرآن الكريم –لا أذكر أي الآيات بالضبط-، فاستحالت أصوات الصراخ والنحيب والتأوه إلى صمتٍ مهيب، أخذت السكينة تتسلل إلى النفوس، وأخذ أتسلل تسلل القطى باتجاه باب الخروج.
بنجاحٍ وصلت، وبينما أهم بالمغادرة أمسك أحدهم بيد طبيبٍ –يبدو أنه مسؤول القسم-، وصرخ به: “شو بتسووا قاعدين؟”، أعاد عليه السؤال بصوتٍ أعلى علّه يفيق من الصدمة، فتأتأ ثم قال: “الوضع خطير جداً بدنا أكثر من عشر غرف عمليات حالاً وهادا أكبر منا”.
خرجت وما زالت الإصابات تتوافد من كل حدبٍ وصوب، لم أصبّ تركيزي سوى في أن أتمكن من مغادرة المكان بأقصى سرعة، لم أطق رائحة الموت –لاحقاً اعتدت عليها-، طفقت أهرول باتجاه مستوصفٍ قريب من البيت، وخلال الطريق مررت بمراكز شرطية مقصوفة، ومراكز يهرب من حولها الناس مخافة القصف.
وصلت المستوصف وقطبت رأسي بعدة غرز، وبينما أنهى الممرض تقطيب رأسي، كنت تلقيت اتصالاً من والدي وطلبت من أن يأتي للمستوصف، دقائق وكنت في البيت، دخلت على أمي وقلت لها بسخرية: “ابنك مصاب يمّة”.
لم أكد أنتهي من رواية ما سبق لأفراد العائلة، حتى بدأت موجة جديدة من القصف، وتكرر المشهد الذي لم أطق أن أراه ثانيةً، في كل لحظةٍ من لحظات الأيام الـ22 لعدوان 2008-2009، وأصبحت تلك المشاهد جزءاً من الروتين الذي نمارسه في كل حرب.
غزة اعتادت على الموت، فمتى تعتاد على الحياة؟!