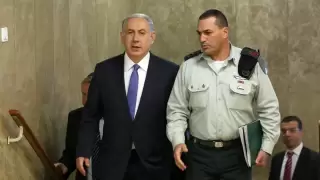مطاعم واحتفالات وفنادق فارهة وحانات وصالات مساج واستجمام، وفي الخلفية صوت يتحدّث بالعبرية يرشدنا إلى "الحياة الأقلّ ظهورًا في الأراضي الفلسطينية"، وثمّة فلسطينيون يستأنس بهم ذاك الصوت "وحشته" في الضفة الغربية، ويتعاطون معه بلغته. هكذا، افتتحت القناة العبرية العاشرة، مؤخرًا، سلسلة تقاريرها عمّا أسمتها "حياة الطبقة الوسطى في الضفة الغربية".
على إيقاع آذانٍ يصدح من مئذنة أحد مساجد الضفة، ووقع أقدام المارّة في شوارع الأخيرة، يبدأ الصحافي الصهيوني حيزي سيمنتوف التجوّل بأريحية في مناطق الضفة، متنقًلا في محطاته بين نابلس وبيت لحم ورام الله.
ينطوي ذاك التجوال على ممارسة خطابية واستجابة لها من الطرف الآخر، إذ تحيلنا مقولة "الحياة بألف خير هنا" على لسان المذيعة الصهيونية التي تقدّم تقرير سيمنتوف إلى مقولة تبريرية أخرى على لسان فلسطينيين في التقرير "نحن شعبٌ يستحقّ الحياة". نحن هنا أمام خطاب يعمل كمصفاة للوقائع والمعطيات، ربما لا ينفي السياق الاحتلالي تمامًا، لكن يصوّره بعدمية إعاقته لـ"الازدهار" الفلسطيني، والانفتاح على الحداثة والعالم، وبالتالي توجيه الخلاصة إلى الشارع الصهيوني بأنّ هؤلاء بغنى عن حلّ سياسي تصوغه "إسرائيل" على وقع "تنازلات" منها.
بالمقابل، بات التبني ما فوق الطبيعي لعبارة استحقاق الحياة والرفاهية من قبل بعض الفلسطينيين استسسهاليًا، وداعيًا للكسل في واقع استعماري يحتاج المجابهة والمواجهة، وهذا ما يتضّح مثلًا في قول أحد منظمي المهرجانات في بيت لحم في التقرير "هدفنا السلام والعدالة، ورسالتنا أننا لا ننسى أن نعيش. أبوابنا مفتوحة للشعب الإسرائيلي جيراننا".
بذلك، يبدو هذا النمط الفلسطيني من الإصرار على الحياة، والذي يُصدّره إعلام العدو، تغطيةً فردانيةً على كل ما يمكن فعله إزاء الاستعمار الصهيوني، بل يصبح نوعًا مُحَّسنًا من تأبيد صورة الضحية التي تستجدي الحياةَ المشروطة من جلادها، والتهرّب المائع من اتخاذ موقف قطعي مناهض للأخير، بعد العمل على استنزافها من تبني النموذج المقاوم المضادّ.
ما بدا لافتًا أيضًا هو اندفاع بعض المتحدثين الفلسطينيين في التقرير إلى استعراض امتلاكهم للغة العدو، على الرغم من أن الصحافي الصهيوني متكلّم جيد للغة العربية، إذ إن هنالك تصورًا ظنيًّا بأنّ التفوّه باللغة العبرية يمنح متكلمها امتيازًا اجتماعيًا وطبقيًا لا يمكن تعويضه باللغة الأم. ويمكن إرجاع هذه المسألة إلى النظرة النفسيّة الدفينة عند بعض المستعمَرين تجاه مستعمِرهم، والتي تنطوي على نوعٍ من محاكاة الافتتان بمن يمتلك القوّة وأدواتها، والتي بالضرورة من ضمنها اللغة التي استحالت وظيفةً قومية بعينها، وتعبيرًا دؤوبًا عن هوّية شعبها.
هكذا، رأينا صاحب مطعم "الريف" في رام الله يجيب على تساؤلات الصحافي الصهيوني بلغته، إلى أن يبادر آخر من الداخل المحتل بالقول "أنا من الرملة طيب وبحكي عبري منيح"، لتنضم لاحقًا زوجته وابنته الصغيرة في التجاوب مع الصحافي بلغته. على مدار التقرير، ضخّم الصحافي من مسألة ارتياد أهل الداخل المحتل للضفة الغربية، إلى حدّ التعامل مع الأخيرة بمنطق يحمّلها أكثر مما تحتمّل، وذلك عبر تصويرها وكأنها مزارٌ سياحي. رأى البعض الإضاءة المبالغ فيها على قضية الداخل تحايلًا على الواقع ودعوة جَهرية للتوجّه السلس نحو العيش في الضفة، والتخلّص منهم تدريجًا.
على أهمية هذه النقاط، لكنها قد تبدو أعراضًا جانبية للموضوع الأهم، وهو أولًا الدخول السلس لهذا الصحافي إلى مناطق الضفة بلا معيقات وإشكاليات لوجستية وسياسية في آن، وثانيًا القبول الشعبي للتعاطي مع محطات العدوّ، خاصةً أننا لا نتحدّث هنا عن نخبة ثقافية لها جمهورها وتخوض معاركها من أجل احتكار تمثيلها للقطاع الثقافي، وبالتالي احتكارها البتَ في تقرير التطبيع من عدمه؛ مثلما حصل مع الجلبة الأخيرة التي صاحبت منع عرض فيلم "قضية 23" لزياد دويري في رام الله.
هنا، يمكننا فرز المسألة إلى مستويين. أولهما مستوى النخبة الرأسمالية التي يمثلّها أصحاب المطاعم وفنادق الخمس نجوم في رام الله، والتي تعاطت مع الإعلام العبري عن سبق إصرار لا خلافَ عليه، ولم ترَ في ذلك أدنى مشكلة؛ ربما بحكم اللغة المشتركة التي يفرضها المال والتجارة مع العدوّ.
أمّا المستوى الثاني، فهو ذو امتداد أكثر شعبيةً، والذي ظهر في التقرير في أحد محلات الكنافة في نابلس. وهنا، لا يمكننا كثيرًا محاكمة النوايا، خاصةً أن الصحافي عمد إلى التحدّث بالعربية مع مرتادي المحال، فلطالما استعان الصحافيون الصهاينة بهذه الحيلة لاختراق الوسط الفلسطيني، وإيهام الأخير بأنّ المحطة ليست صهيونية. لكن على أيّة حال، تظهر هنا إشكالية إبداء التحفّظ على التطبيع بطريقة انتقائية؛ بمعنى اعتبار المسألة احتواء مقبولًا لمن نظّنه غير مؤثّر في الحيز العام، وإقصاءً واجبًا بالمقابل لمن نصنفنه كمؤثّر بمعايير الثقافة والإعلام الجديد.
يتضح من ذلك أنّ التعاطي مع هذه القضية بات محكومًا بالرصيد الشخصي وفاعليته أكثر من الفعل والوَقْع السياسي لذلك، وليس بالضرورة هنا انتظار بيان من لجنة المقاطعة لتحديد محاذير ذلك، كي نبدأ بتحديد اصطفافاتنا ومواقفنا من التعامل مع إعلام العدوّ، خاصةً أن اللجنة تتجنّب، وفق تعبيرها، مساءلة التجارب الفردية، على الرغم من أن الأخيرة بإمكانها جدًا أن تؤسّس لتجارب جمعية مقبولة في التجاوب مع الإعلام الصهيوني، وأشد فتكًا بنا من الاحتفاء بفيلم صانعه مطبّع في أحد مهرجانات رام الله.
إجمالًا، لا يمكننا بناء "كاتالوج" لمعايير التطبيع وقوننتها، وإجبار الناس على الامتثال له بحذافيره، كوننا سنشهد في كل مرّة يحلّ فيها التطبيع تحدياتٍ جديدة تخترق تلك القائمة، دون أن يمنع ذلك من تصنيفها على أنها تطبيع في نهاية المطاف. يُذكّرنا هذا التقرير، إجمالًا، بتقرير آخر أعدّه صحافي صهيوني حول مدينة روابي قبل أشهر قليلة حول "الفلسطيني الحقيقي" القادر على شراء جاكيت بأكثر من خمسمائة دولار؛ بمعنى أن ثمّة خطًا ممنهجًا داخل أروقة الإعلام الصهيوني بإعلاء هذا النموذج وتوسيع مرتاديه، مقابل تحييد النموذج الثوري المضاد، كما أنه لا يمكن لهذا التجوّل المريح لهؤلاء الصحافيين في شوارع الضفة أن يتمّ أو يكون أصلًا بلا امتيازات تسهّل تلك العملية، وأهم تلك الامتيازات هي سلطة التنسيق الأمني.