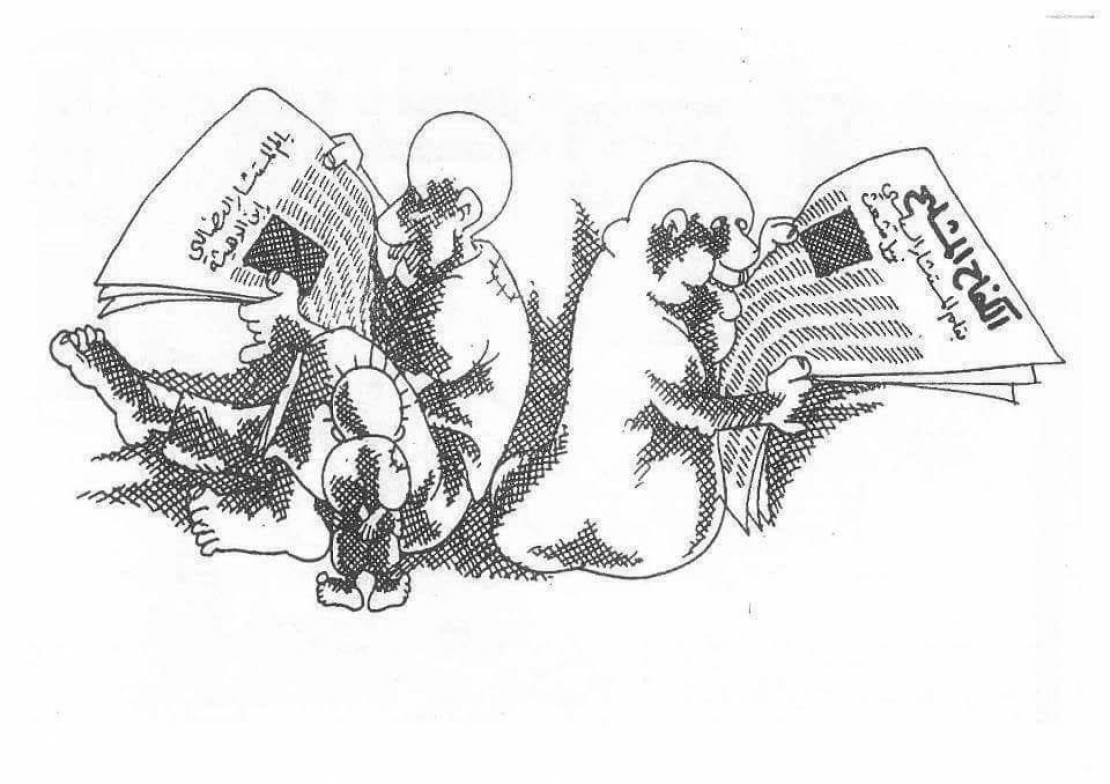حين تتصارع مواقفُ القوى الوطنيّة في بلدٍ يواجه الاحتلال.. كما حصل في الجزائر وإيرلندا والهند وجنوب افريقيا وغيرها، فمن الطبيعيّ أن نسأل عن دوافع هذا الصراع، وأن نحدّد الأطرافَ المستفيدةَ والمتضرّرة منه.
وقد ينتقل الصراع السياسيّ الفكريّ إلى حربٍ داخليّةٍ مسلّحة، خصوصًا إذا لم يكن المستعمِرُ بعيدًا عنه.
كما يتعيّن علينا، ونحن نبحث في تناقضات تلك القوى، فهمُ دور القوى "المحيطة" التي قد تبدو خارج الصورة، أو تحاول لعبَ دور "الوسيط." لكنّها في الواقع أحدُ أسباب ذلك الصراع أحيانًا.
وإذا كان "التحليل الطبقيّ" في مرحلةٍ ما قد طغى على فكر اليسار عمومًا، وأصبح المرجعيّةَ الوحيدةَ في التعامل مع كلّ مفْصل، فإنّه للأسف غاب تمامًا في فترةٍ لاحقة، ولاسيّما في تفسير تناقضات المشهد الوطنيّ الفلسطينيّ.
من هنا وجوبُ رسم صورةٍ، ولو عامّة، للأطراف الطبقيّة الفلسطينيّة المتصارعة، التي يشكّل التناقضُ الفكريُّ والسياسيُّ واجهتَها العلنيّة.
الأقليّة الفلسطينيّة المُهيمنة
إنها الشرائح التي سيطرتْ، منذ قرنٍ تقريبًا، على قيادة المجتمع والشعب والثورة، مثل: الهيئة العربيّة العليا، وقيادة منظّمة التحرير، والسلطة الفلسطينيّة، والمجلس الوطنيّ الفلسطينيّ. وهذه الشرائح لها تعريفاتٌ ورموزٌ تتبدّل في كلّ مرحلة. وقد تكون القيادةُ للعائلات الفلسطينيّة ذاتِها، لكنّ أداءها يتغيّر مع تغيّر أنماط الإنتاج، ومع تغيّر علاقتِها بالمستعمِر الأجنبيّ وأنظمةِ الوصاية الرجعيّة ثمّ الاحتلال الصهيونيّ، ولكنّها في كلّ الحالات تحتلّ الموقعَ المركزيَّ المُقرِّرَ ذاتَه.
هذه الأقليّة الفلسطينيّة تصل بنا، بعد كلّ مرحلةٍ أو معركةٍ أو ثورةٍ أو انتفاضة، إلى كارثة كبرى. حدث هذا على يد طبقة الباشوات وبقايا الإقطاع الفلسطينيّ وكبارِ المُلّاك والتجّار و"الشخصيّات" التي شاركتْ في إجهاض ثورة 1936 ــــ 1939. وحدث الأمرُ ذاته في العام 1947، وفي مراحلَ لاحقة، وصولًا إلى إجهاض مسيرة الانتفاضة الكبرى (1987 ـــــ 1993) والانتفاضة الثانية (2000 ــــ 2005). وما دامت هذه الأقليّة، من أصحاب المال والنفوذ، وهي لا تتجاوز بضعة الآف، تُقصي الأكثريّةَ الشعبيّةَ الفلسطينيّة، وتقبض على مفاتيح القرار السياسيّ الفلسطينيّ، فسيظلّ شعبُنا يحصد المزيدَ من الهزائم والخيبات.
ممّن تتشكّل هذه الأقليّةُ اليوم؟
يصعب تعيينُ فئةٍ واحدةٍ بأنّها "طبقةُ الأقليّة." فهي متعدّدة الأصول، لكنّها تعمل في خدمة الكيان الصهيونيّ والنظامِ العربيّ الرجعيّ والقوى الإمبرياليّة، وذلك عبر شبكةٍ متداخلةٍ من المؤسّسات السياسيّة والماليّة والبنوك والشركات والمشاريع الاقتصاديّة. وقد أصبح لديها حكومةٌ وسجونٌ وأجهزةٌ وسفارات، ولا سيّما بعد تأسيس السلطة الفلسطينيّة سنة 1994.
وهذه السلطة، التي تستهدف المقاومةَ المسلّحة، وتتعاون مع العدوّ الصهيونيّ ودوائرِ الاستخبارات الأجنبيّة، هي أدواتٌ للاحتلال الصهيونيّ ولطبقة اوسلو في آن واحد. وهي تقوم بوظيفة مزدوجة: تكريسُ مصالح الأقليّة الفلسطينيّة، وحمايةُ العدوّ بحيث "يقْبلها" في مجالسه وفي منظومته الأمنيّة والاقتصاديّة، فتُواصل استمدادَ "شرعيّتها" من الاعتراف الرسميّ العربيّ والدوليّ بها "ممثِّلًا" وحيدًا للشعب الفلسطينيّ. والكيان الصهيوني يستجيب إلى مطالب هذه الطبقة المرتهنة به، ويعزِّز موقعَها داخل المجتمع الفلسطينيّ، ويتعامل معها باعتبارها شريكًا مُلحقًا، ويمنحها حصّتَه من سوق "المناطق الفلسطينيّة في يهودا والسامرة،" في إطارِ ما أطلق العدوُّ عليه تسميةَ "السلام الاقتصاديّ."
وبكلام آخر، فإنّ "طبقة" الأقليّة الفلسطينيّة الحاكمة هي شرائحُ عميلةٌ للاحتلال، تتشكّل من مئات كبار الرأسماليين والوكلاء وأصحاب الشركات ومشاريع التعاقد الكبيرة من الباطن مع الاحتلال. أمّا "السلطة الفلسطينية" فما هي إلّا إدارةٌ محليّةٌ لمشاريع هذه الشرائح البورجوازيّة الكبيرة.
وعليه، فإنّ نقدَ مواقف قيادة منظّمة التحرير والسلطة الفلسطينيّة إنّما هو، في الجوهر، نقدٌ لتلك الشرائح الفلسطينيّة المهيمنة التي أسّستْ نظامَ "الواسطة" أو الكومبرادور في الأرض المحتلّة. فهذه الشرائح أحكمتْ سيطرتَها على القرار السياسيّ الفلسطينيّ منذ العام 1974، وسيطرتْ على "الثورة" والمؤسّسة الفلسطينية، وانتقلتْ تدريجيًّا إلى زمن "السلطة." وقد تأتّى لها ذلك الانتقال عبر قبول صيغة "الحكم الإداريّ الذاتيّ،" من خلال مساراتٍ غير ديموقراطيّة وملتوية أقدمتْ عليها القياداتُ والقوى الفلسطينيّةُ التقليديّة، وحزبُها السياسيُّ الأكبر: حركةُ فتح.
مَن هي الأكثريّة الشعبيّة الفلسطينيّة؟
منذ العام 1948 لم نعُد مجتمعًا واحدًا يُقيم فوق أرضه، بل مجتمعات وتجمّعات شعبيّة متعدّدة ومتناثرة ومتباعدة، داخل فلسطين المحتلّة وخارجها، لا تربطها جسورٌ أو روابطُ تنظيميّةٌ أو سياسيّةٌ أو اقتصاديّةٌ واحدة.
من أبرز هذه التجمّعات مخيّماتُ اللاجئين الفلسطينيين. وهذه المخيّمات تجاوزت الستّين. دُمِّر بعضُها، بالقنابل والصواريخ والمجازر الصهيونيّة والعربيّة الرسميّة تارةً، وبالحصار الاقتصاديّ تارةً أخرى. ويتواصل جَلدُها يوميًّا بسياط القوانين العنصريّة، ومشاريعِ الشطب والتوطين. هي أشبهُ ما يكون بـ"كانتونات" تئنّ تحت الحصار والفقر في الوطن المحتلّ والمنافي، وتشكّل مع الطبقات العمّالية والشرائحِ المهمَّشة الأكثريّةَ الشعبيّةَ الفلسطينيّة. وأحزمة البؤس الفلسطينيّة هذه، الممتدّةُ من النقب إلى جباليا، مرورًا بشاتيلا والبقعة واليرموك، ووصولًا إلى المَهاجر البعيدة، تقاتل وحدها اليوم في جُزرٍ ومعازل، ويتملّكها شعورٌ عارمٌ بالخيبة والغضب والخديعة.
هُم مين ونِحن مين؟
إذن، نحن إزاء مجموعتين متناقضتين. ففي حين تعيش الأكثريّةُ الشعبيّةُ الفلسطينيّة في العُزلة والتهميش والإفقار، تتربّع طبقةُ الأقليّة على ثروةٍ من الرساميل تقدَّر بـ40 مليار دولار، وتعيش حياةً مخمليّةً آمنة، وتسكن القصورَ، وتكدّس الثروات، وترسل أولادَها إلى الجامعات والمعاهد المشهورة في الولايات المتحدة وأوروبا، ولا تدفع أيَّ ثمن إنسانيّ في مسار التحرّر الوطنيّ قياسًا بما تقدّمه جموعُ الكادحين.
وكلّما اشتدّ الصراعُ الطبقيّ بين الأقليّة المسيطرة والأكثريّة المسحوقة، حاولت الأقليّةُ حلَّ مأزقها الذاتيّ وأزماتِها الاقتصاديّة والسياسيّة على حساب الحقوق الوطنية للأكثريّة: فتعتدي على حقّ العودة، وتنتقص من حقوق الشهداء والأسرى والجرحى، وتمدّ يدَها إلى جيوب العمّال الفقراء والموظّفين (كما يحدث في قطاع غزّة المحاصر)، وتنهب الأملاكَ العامّة. وهي تحاول خداعَ الأكثريّة بالدجل السياسيّ، وخصوصًا عبر ما يسمّى "الدولة الفلسطينية المستقلّة،" الذي هو في خاتمة المطاف مشروعُ الشرائح البورجوازيّة الفلسطينيّة الكبيرة لا غير. لكنّ هذا المشروع بات محكومًا بالفشل بعد تكشّف نتائجه: فشله في منع الاستيطان، وتهويدِ القدس، وفكِّ الحصار عن غزة، وعودةِ اللاجئين. وباتت سياساتُ العدوّ، بل جرّافاتُه وطائرتُه، تخلق، بمعنًى ما، عواملَ هدم صنم "الدولة الفلسطينية" الذي خلقه هذا العدوُّ بنفسه!
لقد خسرت الأكثريّةُ الشعبّية الفلسطينيّة في كلّ مكان كلَّ شيء تقريبًا، بما في ذلك موقعُها "الطبيعيّ" في "الثورة" ومنظّمةِ التحرير و"المشروعِ الوطنيّ الفلسطينيّ،" لصالح طبقة الرساميل الكبيرة التي سيطرتْ على كلّ شيء. وإذا كانت الطبقاتُ الشعبية هي التي وَضعتْ مداميكَ الثورة ومنظّمة التحرير، فإنّها تجد نفسَها اليوم على قارعة الطريق! نعم، إنّ هذه الطبقات المناضلة والكادحة في فلسطين المحتلة، من عمّالٍ وفلّاحين وصيّادين ومعلّمين ومحامين ومهندسين وطلبةٍ وحِرَفيين وأصحابِ مصانع وورشٍ ومشاريعَ وطنيّةٍ صغيرة، هي التي حملتْ كلّ أعباء الثورة والانتفاضة والعمل المسلّح. وهي الخصم التاريخيّ لسكّان القصور الفلسطينيّة الفارهة، وللكيان الصهيونيّ. وهي، وخصوصًا في المخيّمات، صاحبةَُ المصلحة الأساسيّة في إنجاز مشروعها الوطنيّ: العودة والتحرير .
هذه الكتلة الفلسطينيّة الشعبيّة الكبيرة التي بنَت الثورةَ لا تفتّش عن "دولةٍ" وهميّة، بل تناضل من اجل استعادة الأرض والوطن والحقوق والأملاك المغتصبة. فكيف لطبقاتٍ وتجمّعاتٍ فقيرةٍ وفئاتٍ مهمّشةٍ أن تكون قادرةً على استئناف الثورة المغدورة؟
إنّ تحقيق هذا الهدف يشترط أن تعي هذه الأكثريّة دورَها التاريخيّ في الثورة وحركة التغيير الاجتماعيّ. وهذا الدور لا يقتصر على هزيمة مشروع التصفية الصهيونيّ الأمريكيّ الرجعيّ فحسب، بل سيعني أيضًا دحرَ مشروع الأقليّة الفلسطينيّة في "الدولة" الوهميّة، والانتقالَ إلى زمن الثورة وحركة التغيير الشاملة... لكنْ هذه المرة بقيادة الطبقات الشعبيّة، وذلك لأول مرّة في تاريخ حركة التحرر الفلسطينيّة.
إنّ عباراتٍ وشعاراتٍ مستهلكةً مثل "المصالحة الوطنيّة" و"إنهاء الانقسام" و"الممثّل الشرعيّ الوحيد" و"الدولة الفلسطينية" و"المشروع الوطنيّ" و"الاستقلال" و"الحريّة" و"الشرعيّة" و"المقاومة الشعبيّة" و"القدس" و"حقّ تقرير المصير،" وغيرها وغيرها، لو وضعتَها اليوم على محكّ الاختبار، فستجد أنّ لكلّ طرفٍ فلسطينيّ تعريفَه الخاصَّ لها. والحقّ أنّ إغراق الخطاب السياسيّ في العموميّات، واستخدامَ اللغة والمفاهيم التي تحمل أكثرَ من معنًى ووجه لتبرير الموقف السياسيّ، سياسةٌ ثابتةٌ عند الطبقات الحاكمة ومثقّفيها وأدواتِها الإعلاميّة.
الصراع الداخليّ و"عمليّة السلام"
لا شيء يكشف التناقضَ الفلسطينيَّ الداخليّ، ويحدِّد أطرافَه بدقّة، أكثرَ من الموقف من "عمليّة السلام." ذلك لأنّ الصراع بين طبقة اوسلو والطبقاتِ الشعبيّة الفلسطينيّة يظهر جليًّا في فصول هذه المسرحيّة، ذاتِ الشعار الخادع. فـ"عمليّة السلام" تعني، بالنسبة إلى الشعب الفلسطينيّ، تصفيةً شاملةً لقضيّته، عبر الاستعمار والتطهير ومشاريعِ الشطب والتدجين؛ أمّا بالنسبة إلى طبقة المال الفلسطينيّة، فإنّها عمليّة مربحة وطريقةُ عيشٍ وحياة!
لقد مضى ربعُ قرن على توقيع اتفاق اوسلو، الذي شكّل نقطةَ التحوّل الكارثيّة الرئيسة في مسيرة النضال الفلسطينيّ لصالح الاحتلال والاستعمار والفئاتِ البورجوازيّة الفلسطينيّة الكبيرة. إنّه بدايةُ الانتقال الفعليّ من مرحلة الانتفاضة/الثورة الشعبيّة إلى مرحلة السلطة/ الدولة الوهميّة. وعلى كاهل الغالبيّة الشعبيّة الفلسطينيّة، وحركاتِ المقاومة الشعبيّة والمسلّحة، ستقع مهمّةُ البحث عن طريقٍ ثوريّ بديل يتصدّى لمشروع تصفية قضيّة فلسطين ويحمي وحدةَ الشعبِ والأرضِ والحقوق.
المصدر: الآداب