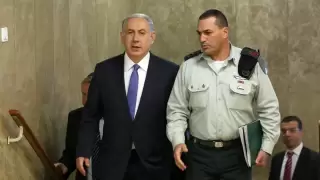من المتعارف عليه لدى الفلسطينيين أنه إذا أُصيبت القاهرة بنوبة برد، فإن أول من تبدو عليها أعراض المرض من حمى وعرق وعطس هي فلسطين بشكل عام وغزة بشكل خاص. هو قدر تاريخي وجغرافي ذلك الذي يربط جمهورية مصر العربية بفلسطين. وتتجسد تلك العلاقة بالذات في الطريقة التي يتعامل بها النظام المصري مع قطاع غزة والتي أخذت أشكالاً مختلفة ومتنوعة من الود الشديد، إلى اللامبالاة، إلى الشيطنة المبالغ فيها كما يحصل الآن.
ما يهمنا في هذا السياق هو الشكل الذي أخذته هذه العلاقة في الفترة الأخيرة وما سبقها من حكم الديكتاتور مبارك ببعده الأمريكي-الإسرائيلي وفترة حكم الإخوان المسلمين التي تميزت بغلبة الأيديولوجي على السياسي في السياسة الداخلية والعكس في السياسة الخارجية، وبالذات فيما يتعلق بالعلاقة مع كل من إسرائيل وأمريكا وانعكاس ذلك على القضية الفلسطينية.
كان من أوائل القرارات التي اتخذها نظام حسني مبارك فور اندلاع ثورة يناير 2011 هو منع كل من يحمل جنسية فلسطينية من دخول مصر وإغلاقُ معبر رفح بالكامل، وهو المنفذ الوحيد لقطاع غزة على العالم الخارجي. وكالعادة لم تبدِ منظمة التحرير الفلسطينية ولا السلطة الفلسطينية الحاكمة في رام الله، أي نوع من الاحتجاج يتناسب مع دورهما التمثيلي، مع عدم قدرة حركة حماس الحاكمة في قطاع غزة على إبداء أي رأي مؤثر، بل محاولتها قمع أي مظاهر شعبية مؤيدة للثورة المصرية في بداياتها.
وكانت قرارات نظام مبارك امتداداً لسياسة قمعية مهولة بخصوص فلسطينيي القطاع تطورت الى المشاركة بشكل مباشر في تشديد الحصار الخانق الذي فرضته إسرائيل منذ عام 2006، والتواطؤ الكامل مع حربها الهمجية عام 2009، لدرجة أن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط لم يبد أي حزم سياسي في حياته المهنية إلا فيما يتعلق بحصار قطاع غزة من خلال تهديده للسكان بكسر أرجلهم في حال "تعدوا على الأمن القومي المصري" بعد أن قاموا بفتح فجوة في الجدار الحدودي وتوجهوا لمدينة العريش لشراء الأدوية والمواد اللازمة. أضف إلى ذلك الموقف الصادم للعالم العربي برمته حينما وقف نفس وزير الخارجية بجانب نظيرته الإسرائيلية، تسيبي ليفني، عندما أعلنت الحرب على غزة عام 2008 من القاهرة. ومن الطبيعي أن يصاحب هذه السياسة عملية شيطنة غير مسبوقة لفلسطينيي القطاع ووضعهم في بوتقة واحدة تسمى "حماس" التي أصبحت مرادفة "لغزة".
وكان سقوط نظام مبارك قد صاحبته توقعات فلسطينية مبالغٌ فيها يتصدرها فتح معبر رفح فورا وبشكل دائم والسماح بعبور الأفراد والبضائع، وبالتالي التخلص من مبرر وجود الأنفاق الضروري على الحدود، بالإضافة الى التعامل الإيجابي مع ملف المصالحة (الأزلي) على اعتبار أن النظام السابق كان بالضرورة منحازاً لليمين الفلسطيني العلماني لاعتبارات داخلية وخارجية. لكن سقوطه المدوي وسيطرة المجلس العسكري لفترة انتقالية لم يؤديا الى رفع الحصار الخانق عن قطاع غزة ولا إلى تحسن في الأداء السياسي المصري بخصوص فلسطين بشكل عام. واستمر عمل الأنفاق لتعويض النقص الهائل في المواد الأساسية التي لا تسمح إسرائيل بدخولها، والفتح الجزئي لمعبر رفح لفترة زمنية محدودة للغاية لا تلبي المطالب الأساسية ل1.7 مليون فلسطيني بحرية الحركة. وتم تأجيل الأمل المنشود الى نتائج الانتخابات الرئاسية الأولى بعد سقوط مبارك على اعتبار أن صلاحيات الرئيس المنتخب ديمقراطياً ستخوله اتخاذ موقف وطني-سيادي، ناهيك عن البعد القومي والإسلامي برفع الحصار فوراً عن قطاع غزة من خلال فتح معبر رفح، ومراجعة اتفاقيات كامب ديفيد والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل والاستجابة للنداء الفلسطيني بمقاطعة إسرائيل وعدم الاستثمار فيها وفرض عقوبات عليها واعتبار ذلك أضعف الإيمان. بل أن التوقعات الإيجابية وبناءً على اللحظة الثورية توصلت إلى قناعةٍ بأن أول زيارة للرئيس المنتخب الجديد خارج مصر ستكون لقطاع غزة.
وبفوز المرشح الإخواني تباشر البعض المؤيد لحركة حماس في قطاع غزة خيراً، وتوقع البعض الآخر أن يقوم الرئيس الإخواني الجديد بالقيام بالحد الأدنى المتوقع منه على الصعيد الفلسطيني. ومن المفارقات أن أول زيارة للرئيس المنتخب كانت إلى دولة كانت قد أعلنت ومنذ البداية عداءها للثورة المصرية المجيدة، المملكة العربية السعودية. ولم تكن غزة على أجندة الزيارات الرئاسية بأي شكل من الأشكال. والآن وبعد عام من حكم ممثل الإخوان وسقوطه يبرز السؤال المهم عن مدى التزام الرئيس بالقضية الفلسطينية والعمل على دعمها بشكل يأخذ بعين الاعتبار المصلحة الاستراتيجية المشتركة بين مصر وفلسطين.
والواقع أن الرئيس الإخواني وحركته فشلا فشلاً ذريعاً في أول اختبار لهما بسبب غياب البعد الثوري-التغييري في الأيديولوجيا المسيطرة على الحركة كما اتضح من مشاركتها المتأخرة في ثورة 25 يناير ومحاولتها المستميتة قبل ذلك لاسترضاء نظام مبارك وتحالفها مؤقتاً مع المجلس العسكري وتأييده في أحداث محمد محمود وماسبيرو, وغياب الرؤية السياسية واضحة المعالم لدرجة أن المستمع لخطابات الرئيس كان يعتقد أنه يستمع لخطبة جمعة أو جلسة يلقي فيها كبير القوم كلمة لأبناء عشيرته. ولكن بخصوص العلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة غابت الشعارات المشبعة بأيديولوجيا ثقيلة التي كانت تميز الخطاب الإخواني قبل الوصول للسلطة. وكالعادة كانت نظرية المؤامرة دائماً جاهزة ولوم "المؤامرات الدولية" لا يغيب عن تبرير الفشل الذريع في السياسات الداخلية والخارجية. وكانت الممارسات السياسية على الأرض تشير في اتجاه آخر؛ فالحقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية حافظت على علاقاتها المتميزة مع الحكومة المصرية التي استماتت بدورها أن يتم قبولها أمريكيا. والثمن هو كالعادة المحافظة على علاقات ودية مع إسرائيل.
وعلى العكس مما تم الترويج له قبل سيطرة الإخوان على الحكم، فقد حافظ النظام الإخواني على العلاقات مع إسرائيل وأصبحت السياسات البراغماتية هي المسيطرة. ولم يكن هناك أي محاولة لوضع حدٍ لاتفاقية السلام المبرمة عام 1979، ولم يتم حتى إخضاعها لاستفتاء شعبي كما توقع البعض. ولزيادة الطين بلة، ازداد الحصار على قطاع غزة. فقد تم إغلاق جميع الأنفاق تقريباً وأصبح معبر رفح يعمل "بالقطارة" والعلاقات المصرية-الإسرائيلية تم التعبير عنها بعد أشهر قليلة من انتخاب محمد مرسي رئيساً لمصر من خلال رسالة مبالغ في وديتها وجهها للرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز يطلب فيها قبول تعيين السفير المصري الجديد في تل أبيب. وقد عبر الرئيس في تلك الرسالة عن "شديد الرغبة في أن أطور علاقات المحبة التي تربط لحسن الحظ بلدينا" وأضاف موجها الكلام لبيريز الذي وصفه "بالصديق العظيم": "لي الشرف بأن أعرب لفخامتكم عما أتمناه لشخصكم من السعادة، ولبلادكم من الرغد". وتم توقيع الرسالة ب"صديقكم الوفي محمد مرسي".
وقد تميز حكم الإخوان بفشل ذريع في إرسال حتى إشارات بتطبيق ولو جزءا بسيطاً من شعارات ثورة يناير: عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة انسانية. بل على العكس من ذلك، فقد أصبح الأمن مفقوداً بالكامل مع شبه انهيار اقتصادي وفقدان وزن مصر العربي والدولي، وصولاُ لتهديد أمنها المائي من أثيوبيا. وأصبحت سيناء شبه مسيطر عليها من قبل جماعات تكفيرية وإسرائيل تلعب بها كما تشاء لدرجة اختطافها مواطناً فلسطينياً منها. وعادة ما يدفع أهل غزة ثمن أي عمل إجرامي في سيناء.
وهذا بالضبط ما حصل مع تبني الرئاسة الإخوانية موقفاً براغماتياً يمينياً من العلاقات مع إسرائيل وسياساتها الاحتلالية والعنصرية. بل أصبح المطلوب سياسياً "تَفَهُّم" ظروف العمل السياسي وضرورة التحلي "بالواقعية" وعدم طلب المستحيل. اختفت الشعارات الأيديولوجية البراقة -"بالملايين عالقدس زاحفين"- ولم يقم الرئيس المصري المنتخب ديمقراطياً نتيجة ثورة عارمة حتى بفتح معبر رفح. فالواقعية، حسب فهم حركة الأخوان وممثلها في رئاسة الجمهورية، تتطلب الالتزام بالاتفاقيات الدولية والحفاظ على علاقات متميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية والقبول بقروض ربوية من صندوق النقد الدولي والحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل لدرجة "توسط" الرئاسة المصرية لإبرام اتفاقية وقف اطلاق نار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في نوفمبر 2012, وفشلها حتى كوسيط بالتدخل لإجبار إسرائيل على الالتزام بما وقعته.
وفي اعتقادي أن مرسي كان قد قرر استخدام الانتصار الفلسطيني ودور الوسيط الذي لعبه لتحقيق انتصارات داخلية من خلال الانقضاض على عملية التحول الديمقراطي حيث أصدر إعلانه الدستوري الشهير والذي يخوله صلاحيات غير مسبوقة في التاريخ المصري المعاصر بعد ثلاثة أيام من انتهاء الحرب على غزة حيث ينص الإعلان الدستوري على أن" الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية."والواقع أن مصر الإخوان لم تقف الى جانب غزة خلال تلك الحرب الهمجية التي جاءت لتثبت خطأ الأمل الكاذب الذي عبرت عنه بعض القيادات الغزّية بعد فوز الإخوان في الانتخابات الرئاسية حيث كان رئيس وزراء حكومة غزة قد قال أن إسرائيل لن تتجرأ على ضرب غزة عندما يأتي الإخوان المسلمون إلى الحكم: "إننا واثقون أن مصر، والثورة التي يقودها مرسي، لن توفرا غطاء لأي اعتداء جديد أو حرب جديدة على غزّة...إننا واثقون أن مصر والثورة بقيادة مرسي لن تشاركا بأي طريقة في محاصرة غزّة."
وعلى العكس من هذا التمني الرغبوي فإن حرب 2012 على غزة راح ضحيتها أكثر من 200 فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء، كما تم إجهاض ما أُعتُبر صموداً تاريخياً حققه الشعب الفلسطيني. حيث أن أهم ما أُعلن عنه وقتها من رفع للحصار عن القطاع لم يتم تطبيقه حتى لحظة إسقاط مرسي. وبالتالي انتقلت سياسات مبارك تجاه القضية الفلسطينية وبالذات تجاه غزة، إلى الرئيس الإخواني الذي لم يتجرأ على تحدي "جريمة ضد الإنسانية" تمارس على حدوده، جريمة أدانتها كل منظمات حقوق الإنسان ولجان الأمم المتحدة على أنها "عقاب جماعي" وتصل إلى "إبادة جماعية بطيئة". وذهبت كل التوقعات والأمنيات أدراج الرياح وتم الطلب من الضحية الفلسطينية أن "تتفهم" مرحلة "التمكين" التي ينتهجها الإخوان وألاّ تطالب بالمستحيل -وكأن المطالبة بفتح المعبر لعبور البضائع والناس عملاً ثورياً طوباوياً.
وهكذا انتقلت السياسة المباركية-الساداتية المعادية للفلسطيني إلى النظام الحالي ولكن بشكل يشيطن كل ما هو فلسطيني. بل أن قطاع غزة يشهد في هذه اللحظة تشديداً هائلاً لهذا للحصار من خلال إغلاق المعابر والأنفاق بشكل كامل وكأن التاريخ يعيد نفسه كمأساة وملهاة في نفس الوقت. وعادت أيام الحصار الأولى بتحريض فاشي غير مسبوق سيطر على العديد من وسائل الإعلام المصرية الخاصة منها بالذات والممولة من قبل رجال أعمال محسوبين على نظام مبارك وبعض الدول الخليجية المعادية لثورة 25 يناير وانعكس على الطريقة التي يُعامل بها الفلسطيني في المطارات و على المعابر. مرة أخرى يصبح الفلسطيني (الآخر) للسلطات، (الآخر) الذي تستطيع إسقاط كل العقد الأمنية والنفسية عليه كونه الطرف الأضعف الذي لا تمثله حكومة قوية على الإطلاق.
على العكس من ذلك فإن منظمة التحرير الفلسطينية لم تصدر أي بيان يدعو الحكومة المصرية للتخفيف من الحصار الخانق أو السماح للفلسطيني بدخول المعبر أو المطار بشكل يليق بآدميته. بل أن هناك شعور بالتشفي بسبب سقوط نظام الإخوان وما يمكن أن يخلقه من صعوبات جمة على حركة حماس. ناهيك عن المأزق الذي تمر به الحكومة الغزية وتخبطها بعد سقوط الرئاسة الإخوانية.
وأصبح المواطن الفلسطيني الذي ينتمي لقاع التصنيف العنصري الذي فرضته إسرائيل، أي لاجئو غزة، يتعرض لأقصى درجات الإهانة ونزع الإنسانية على القنوات الفضائية المصرية. فمن عمرو أديب الذي يتشفى فيما يحصل لفلسطينيي غزة، إلى زوجته لميس الحديدي التي لا شك لديها بتدخل "حماس" وبالتالي الكل الفلسطيني في شؤون مصر الداخلية، إلى توفيق عكاشة الذي دعا الجيش المصري لضرب قطاع غزة عسكرياً، إلى يوسف الحسيني الذي هدد بمعاقبة الفلسطينيين والسوريين، إلى ذلك الجنرال القادم من أفلام الأبيض والأسود ليكتشف أن "محمد مرسي ده أصله فلسطيني".
[caption id="attachment_25676" align="aligncenter" width="400"] أحد ضيوف برنامج القاهرة والناس الذي ادعى ان مرسي فلسطيني الأصل[/caption]
أحد ضيوف برنامج القاهرة والناس الذي ادعى ان مرسي فلسطيني الأصل[/caption] ولا شك أن هذه الحملة المسعورة في عنصريتها الشوفينية والتي تُحَمِّل غزة كل مشاكل مصر الداخلية من أزمة الوقود إلى العمليات الإرهابية في سيناء، تساهم في خلق مناخات بالضرورة مضادة للثورة وتخدم المنطق الفلولي العائد بقوة. فبمجرد الإعلان عن نهاية حكم الإخوان قامت السلطات المصرية باغلاق معبر رفح وتم مرة أخرى إصدار قرارات بوضع قيود أمنية على دخول الفلسطينيين الى مصر مع تدمير شبه كامل لجميع الأنفاق. ومن المقلق جداً غياب الأصوات المصرية الثورية في هذا الخصوص، مع بعض الاستثناءات الجريئة. فكل العمليات الإرهابية في سيناء قد أدينت من الكل الفلسطيني شعبياً ورسمياً.
ولم يتم حتى هذه اللحظة إثبات أي تدخل فلسطيني في أيٍ من الأحداث الجارية في مصر وبالذات في سيناء. ولكن علينا أيضاً أن نتذكر أنه لو تم القبض على أفراد وإدانتهم- وهذا ما لم يحصل - فإن هذا لا يبرر أي عقابٍ جماعيٍ تتخذه السلطات المصرية ضد سكان القطاع. فالعدد الكبير للجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ضد مصريين بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد، وآخرها قتل خمسة جنود إثر غارة إسرائيلية داخل الأراضي المصرية عام 2011، لم يؤد لا إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ولا التهديد بالتدخل العسكري، ولا قطع الإمدادات بالغاز، ولا أي نوع من التضييق على الزوار الإسرائيليين لمصر عبر طابا.
أليست مشكلة سيناء مشكلة مصرية بامتياز؟ فمن المعلوم للقاصي والداني أن نظام مبارك كان قد أهمل سيناء لدرجة كبيرة وتم التعامل مع أهلها وكأنهم مواطنو درجة ثانية ولم توفر الخدمات اللازمة لهم مع أنهم خط الدفاع الأول لحماية أمن مصر القومي. إن غزة تمثل الامتداد الطبيعي لشبه جزيرة سيناء وبالتالي هي جزء من الأمن القومي المصري. من المهم جداً في هذه اللحظة التاريخية أن تقوم الثورة المصرية المجيدة بمواجهة فلول النظام السابق، الثورة المضادة التي ترى أن أضعف خاصرات الثورة هي الخاصرة الفلسطينية. فلا غرابة إذن من تصريحات مذيعي الفلول الذين استماتوا في الدفاع عمن باع مصر وحاربوا ثوار 25 يناير بشراسة غير معهودة. هم من قال عنهم شاعرنا الكبير الفاجومي أحمد فؤاد نجم: "الثوري النوري الكلمنجي، هلّاب الديب الشفطنجي...يتمركس بعض الأيام، ويتأسلم بعض الأيام، ويصاحب كل الحكام، وبستاشر ملة".
ولكن الواقع يشير إلى أن هناك حباً جماً يكنّه الشعب المصري لفلسطين وأهلها، حباً لا يتنكر للدماء المصرية التي سالت على أرض فلسطين منذ عام 1948 في دفاع عن أمن مصر القومي الحقيقي. برز ذلك، على صعيد المثال، في البيان الذي أصدره العديد من المثقفين والسياسيين ضد الحملة الإعلامية المسعورة على الشعب الفلسطيني حيث طالبوا بلغة واضحة "المسئولين بإصدار بيان سريع عن سياسة مصر والتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني مع إصدار أول خططها السياسية إزاء الأوضاع الراهنة، ومع الالتزام بالمحافظة على كافة حقوق أبناء الشعب الفلسطيني فى مصر من مودة ورعاية وحماية، والتزام كل القوى السياسية والمدنية فى مصر بطرح خطة فورية للتوعية لجماهيرها بقضايا الشعب الفلسطيني والتزامات مصر نحوها تبرمج في خطة عملها المباشرة مع كافة مستويات الجماهير المصرية."
كما ناشدوا كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمبثوثة بوسائل التواصل الاجتماعي أن يراعوا فيما يقدمونه لجماهير مصر كل قواعد المصداقية، والتحقق، وتجنب أية إثارة فيما يخص الشعب الفلسطيني. وأكد البيان أن مصر كانت "قاعدة أساسية طوال تاريخها الحديث، وعلى المستوى الشعبي خاصة، لنضال الشعب الفلسطيني، واعتبار القضية الفلسطينية قضية مصرية خالصة."
الرسالة كانت ولا زالت تأتي من الشعب للشعب، كما عبر عنها البيان المذكور بعيداً عن الشعارات الأيديولوجية الطنانة والشيطنة المشبوهة التي وضعت كما يقول البيان "القوى الوطنية الصادقة فى الإحساس والفهم لحقيقة مشاعر أبناء فلسطين وقضيتهم العادلة، أمام موقف مثير للحرج، والشعور بالتقصير فيما يجب أن تقوم به القوى الوطنية والديمقراطية فى مصر من أشكال الدفاع عن وضع الفلسطينيين والقضية الفلسطينية. ويتوجهون لجماهير الشعب الفلسطيني بأسمى آيات الترحيب ومشاعر المحبة والثقة الكاملة فى إخلاصهم وتقديرهم لظروف الشعب المصرى نفسه."
تلك مصر التي نريدها، مصر التعددية والديمقراطية والحرة، كاملة السيادة على أرضها من حدود ليبيا غرباً حتى فلسطين شرقاً، مصر التي تطبق الشعارات التي استشهد من أجلها خالد سعيد، مينا دانيال، عماد عفت، سليمان خاطر، سالي زهران وغيرهم من "الورد اللي بيفتح في جناين مصر".
*نشر هذا المقال في موقع شبكة السياسات الفلسطينية.