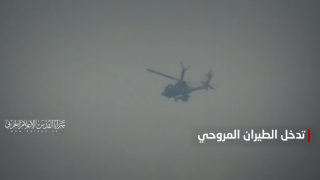دخل الوضع الفلسطيني مرحلة جديدة بعدما نُشِرَت خرائط ما يسمى بـ«صفقة القرن»، بالنسبة إلى الضفة الغربية أو بتحديد أكثر بعد أن قررت حكومة بنيامين نتنياهو البدء بضمّ الأغوار والمستوطنات، وبعد أن أعلن ضمّ القدس كاملة، واعتبارها عاصمة الكيان الصهيوني. وأُضيف السعي المحموم للسيطرة على المسجد الأقصى، والتمهيد لاقتسام الصلاة فيه، وإلغاء ما كان يُعرف بالأمر الواقع أو «الستاتيكو». إذا كانت المرحلة السابقة التي عُرفت بمرحلة اتفاق أوسلو، وما بعد «أوسلو»، قد انتهت عملياً بانتهاء الاتفاقات المترتبة عليه، لو بالإعلان فقط، من جانب الرئيس محمود عباس وسلطة رام الله، ذلك يعني الدخول في مرحلة جديدة مختلفة نوعياً.
«أوسلو» وما بعده من اتفاقات مثّل التنازل عن 78% من فلسطين (ما يسمى حدود ما قبل حزيران 1967)، وهيّأ لعملية استيطان الضفة، ومصادرة الأغوار عملياً، وتهويد القدس وتعريض الأقصى للاقتسام، والسيطرة الأمنية الداخلية عليه وعلى باحته. إن المرحلة الجديدة تتمثل في السعي الصهيوني لضم شرق القدس وأجزاء كبيرة من الضفة، بل الضفة كلها، بما فيها وما تبقى من أرض ومناطق أُخضعت عبر «صفقة القرن» (جريمة القرن) للمفاوضات المباشرة، ما يعني أن كلّ من يظن أن خرائط الصفقة تركت شيئاً للفلسطينيين، فهو واهم، تماماً كما كان من ظن أن «أوسلو» ترك الضفة للفلسطينيين.
فقد أثبتت التجربة أن ما يُترك للتفاوض يعني تركه للاستيطان خطوة وراء خطوة، تمهيداً لضمه وتهويده. فما تركته خرائط ترامب ــ نتنياهو هو تمهيد لاستيطان لاحق، ثم لإكمال الضم الكامل لكلّ الضفة مع التمهيد للسيطرة المطلقة على الأقصى.
من هنا، إن المرحلة الجديدة تتسم بضم الضفة كلها، والقدس كلها، وتهديد الأقصى بالتقسيم، ثم بالهدم لحساب بناء الهيكل المزعوم. هذه الحقيقة تعني انتهاء وظيفة السلطة، أو تحويرها باتجاه تغطية الضم وحمايته وليس تغطية الاحتلال والاستيطان، كما كانت الحال في المرحلة السابقة، مرحلة «أوسلو» وما بعدها، الأمر الذي يعني بدوره أن كل الأعذار والسياسات الوهمية التي سوّغت وظيفة السلطة، أي إقامة دولة على الأراضي التي احتلت في حزيران 1967، قد انتهت.
وأصبح على «السلطة» إن أرادت البقاء والاستمرار أن تتحول إلى متواطئ مع عملية الضم نفسها، وبلا هدف سياسي. هذا بالتأكيد يضعها في موقع حتى خيانة دورها السابق، ومشروعها السابق. فبأيّ أعذار يمكن أن يُسوّغ اليوم للبقاء في السلطة، بأجهزتها الأمنية، وبسياساتها التي حرّمت المقاومة والانتفاضة.
كان من الممكن إدخال الاختلاف الذي نشأ مع «أوسلو» وبعده فرضياً أو جدلاً، حتى لو بصعوبة حتى الاختناق، في إطار الاختلاف السياسي والمبدئي، برغم مناطحته الثوابت الفلسطينية: رفض التنازل عن الأرض الفلسطينية (أرض نكبة 1948) ورفض الاعتراف بالكيان الصهيوني، ورفض التخلّي عن استراتيجية المقاومة، ومنطلقات «فتح» وميثاقيْ 1964 و1968 لـ«منظمة التحرير الفلسطينية».
لكن أين يُمكن إدخال بقاء السلطة والسياسات السابقة في الوضع الجديد الذي يمضي إلى ضم آخر حبة تراب من الضفة؟ الجواب السياسي غير ممكن. أما المبدئي والواقعي، فمحال، لأن المضي في الضم يعني المضي في التنازل عن الضفة، وضياعها عينك عينك.
قيادة «فتح» والسلطة تواجهان مأزق وجود، وليس مأزقاً سياسياً أو فشلاً لسياسات محدّدة، أو اتّهاماً بالفساد أو الاستبداد أو العجز أو التفريط، أو أيّ تهمة يمكن أن توجّه إلى سلطة وحركة سياسية، أصحّت أم لم تصح. إن ما تواجهانه هو مصادرة (ضم) القدس والأقصى وأجزاء من الضفة، وما تبقى منها سيزحف إليه الاستيطان ثم المصادرة والضم. ثم إن بقاء السلطة مؤقت بينما يُنجز الضم الكامل.
بعبارة: على عباس وقيادة «فتح» أن يدركا أن زيت السلطة انتهى، وما تبقى من السياسة انتهى. وإذا كان من الممكن العيش في السياسة بلا مبادئ، كيف يمكن العيش بلا سياسة، يمكن أن تسوّغ، ولو بحجج واهية أو آمال خلّب.
الضم، إذا لم يُواجَه ويُقاوَم ويوضَع له حدّ، بل إذا لم يُقاوَم الاحتلال والاستيطان من حيث أتى، الأفضل الانسحاب لا الاستمرار في هذه النجاسة والدناسة إلى حدّ الخيانة، لأن الحفاظ على السلطة في ظل الضم يفسدها إلى حد تمرير الضم مقابل البقاء، وهي حالة لا يرضاها فلسطيني، ومن يرضاها، تبرأ منه أبناؤه وأحفاده، ولسوف يُواجِه انفجاراً لا محالة. طبعاً الأفضل أن يقبع في بيته، أو ينسحب إلى الخارج من لا قِبَل له على المواجهة، كي تتشكل وحدة وطنية تخوض انتفاضة، راح الشباب وغالبية الشعب يتفلتون لإطلاقها، وهم يرون الضم يزحف، والأقصى يُعتدى عليه.
على أن ما يزيد هذا التردّي مأساة كون موازين القوى في غير مصلحة حكومة نتنياهو الذي يراهن على ترامب المتداعي، وعلى سلطة يتوقع منها أن تسهّل الضم بسياساتها التي تكتفي بإعلان رفض الضم و«صفقة القرن»، ثم تترك القدس والأقصى والضفة للضياع، بدلاً من توحيد الصف الفلسطيني، وإطلاق انتفاضة تُسقط سياسات الضم، بل يمكنها أن تدحر الاحتلال، وتفكك المستوطنات، بلا قيد أو شرط. الوضع الدولي كلّه ضد الضم، وحتى إدارة ترامب منقسمة، والداخل الصهيوني ترتفع فيه أصوات تحذّر من الانتفاضة والسقوط.
والمهرولون من العرب في أسوأ أحوالهم خزيّاً وضعفاً مع فقدان الجرأة على أن يقولوا نحن مع الضم. فكيف يجوز ألّا تتشكل وحدة وطنية عاجلة تطلق انتفاضة تفيد من هذه المعادلة التي لا تسمح بإسقاط سريع لنتنياهو فحسب، وإنما بدحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات بلا قيد أو شرط.
إذا كان عباس وقيادة «فتح» لا يستطيعون أن يروا كل هذا، على فصائل المقاومة الأخرى أن تحسم أمرها، وتعلن لقاء لتحقيق وحدة وطنية تطلق الانتفاضة بحضور «فتح» (هذا للفضل) أو بغيابها، لأن الوضع الجديد الذي يتّسم بضم القدس، والسعي للسيطرة على الأقصى، وضم أجزاء كبيرة (أو «صغيرة») من الضفة، يفرض بدوره، إلى جانب ميزان القوى العالمي والإقليمي والشعبي العربي والإسلامي والعالمي الملائم، أن تتخطى الفصائل سياساتها السابقة: «البحث عن المصالحة»، «إعادة بناء منظمة التحرير»، «ترتيب البيت الفلسطيني»...بانتظار موافقة «فتح»، أو بانتظار مجيء «فتح»، وذلك بالدعوة إلى لقاء وحدة والسعي لإطلاق الانتفاضة. إذا لم تستجب «فتح»، عليها أن تواجه وحدة وطنية فلسطينية واسعة لمواجهة الضم، أو تلبية متطلبات المرحلة الجديدة، أو الوضع الجديد.
الوضع السابق كانت له سياساته. والوضع الراهن يتطلّب سياسات تلائمه. صحيح أن الكرة في ملعب «فتح» أولاً، لكن ثمة كرة أيضاً في ملعب فصائل المقاومة. ولعلها تساعد «فتح» على تصحيح سياساتها حين ترى وحدة واسعة تتشكل دونها ضد ترامب ــ نتنياهو وسياسات الضم.