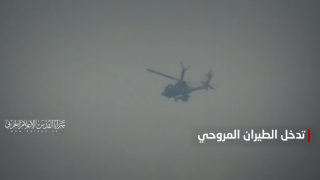يعيش الحقل السياسي الوطني الفلسطيني، الذي تهيمن عليه منظمة التحرير الفلسطينية منذ أواخر الستينات، حالةَ تفكك منذ إنشاء السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو.
فماذا كان تأثير هيمنة منظمة التحرير الفلسطينية؟ وما هي تداعيات تفكك الحقل السياسي على الجسم السياسي الفلسطيني؟ وإلى أي مدى أثَّر تفككُ الحقل السياسي في الحقل الثقافي وفي مساهمته في الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية؟ يجيب هذا التعقيب على هذه التساؤلات ويناقشها.
بدأت هيمنة منظمة التحرير الفلسطينية على الحقل السياسي الفلسطيني بُعيد معركة الكرامة في عام 1968، ممَّا مكنها من إقامة علاقة مركزية مع التجمعات الفلسطينية في فلسطين التاريخية والأردن وسوريا ولبنان والخليج وأوروبا والأمريكيتين، أي علاقة قائمة بين مركز وأطراف تقاد من مركز قيادي واحد بغض النظر عن مكان وجود هذا المركز. وعمومًا قبلت هذه التجمعات بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها ممثلتهم الشرعية والوحيدة رغم المؤثرات الخارجية المفروضة عليها بما فيها اعتمادها الشديد على المعونات الأجنبية، والتقلبات في علاقتها مع البلد الذي تقيم فيه، وعلاقاتها الإقليمية والدولية. وما عنته هذه العلاقة هو تغييب الشروط الخاصة لكل تجمع وخصوصية أوضاعه وبالتالي المهام الوطنية والاجتماعية والتنظيمية المطروحة عليه.
استطاعت منظمة التحرير الفلسطينية من موقعها المهيمن أن تكرس مفهوماً للسياسة كشأن يخص نخبة صغيرة فقط من الشعب. وهو مفهوم كان واسع الانتشار عربيا ودوليا، لكنه يحمل مخاطر شديدة الوقع في الشرط الفلسطيني بفعل تشتت الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل نيل الحرية. وقد ساعدَ في تكريس هذا المفهوم نشوءُ منظمة التحرير ونشاطها في بيئة سياسية إقليمية ودولية غير صديقة للديمقراطية كمفهوم وممارسة سياسية. بل كان يُنظَر إلى الديمقراطية باعتبارها مفهوما غربيًا استعماريًا. وهيمنت على الصعيد العربي أنظمةٌ ذات أيديولوجيات قومية شمولية، وأنظمة ملكية وأميرية ثيوقراطية سلطوية. وفي علاقاتها الدولية نجحت منظمة التحرير وفصائلها في صياغة تحالفاتها الأساسية مع دول اشتراكية ومن العالم الثالث، وقد غلب على هذه الدول تغييبُ الديمقراطية السياسية عن مجتمعاتها. وعزَّز هذا الفهم النخبوي والأبوي للسياسة السمةُ الريعيةُ التي باتت من مكونات مؤسسات منظمة التحرير وفصائلها بحكم اعتمادها على المساعدات والدعم من دول عربية وبلدان اشتراكية وجميعها أنظمة غير ديمقراطية، بل ومانعة للحريات الفردية والعامة.
وثمة سمة ثالثة لهيمنة منظمة التحرير الفلسطينية وتتمثل في أن فصائلها خضعت مبكرًا للعسكرة النظامية لأسباب عدة منها تورط المنظمة في صدامات مسلحة مع أنظمة عربية، واستهدافها الدائم من طرف إسرائيل. وقد ساهمت العسكرة النظامية - وليس المقصود هنا التسليح الشعبي وتشكيل المجموعات الفدائية - في تسويغ المركزية الشديدة في علاقة القيادات السياسية مع الشعب.
واجهت مؤسسات منظمة التحرير وفصائلها من السبعينات وحتى التسعينات هزات وصدمات عنيفة نتيجة تقلبات الوضع الإقليمي والدولي. ومنها خروج المنظمة من الأردن عقب صدامات أيلول المسلحة في 1970-1971، والحرب الأهلية في لبنان 1975 واجتياحها إسرائيليًا في 1982 وخروج المنظمة منه ووقوع مجزرة صبرا وشاتيلا، واندلاع حرب ضد المخيمات الفلسطينية 1985-1986 في لبنان، وتفجر الانتفاضة الأولى في الضفة الغربية وقطاع غزة في أواخر 1987 وهي الفترة التي اقتحم فيها الإسلامُ السياسي الحقلَ السياسي الفلسطيني (1988). ومن المتغيّرات أيضًا انهيارُ الاتحاد السوفيتي في أواخر 1989، وحرب الخليج في 1990-1991 التي أعقبها حصارٌ مالي وسياسي على منظمة التحرير الفلسطينية ممَّا أفقدها الكثير من تحالفاتها ومصادر دخلها.
تداعيات تفكك الحقل السياسي
لم تقرأ النخب الفلسطينية السياسية في الانتفاضة الأولى الحاجة إلى إعادة النظر في بنية الحركة الوطنية الفلسطينية، ولا ضرورة مراجعة بنية العلاقة المركزية بين القيادة وبين تجمعات الشعب الفلسطيني المختلفة. وفشلت قيادة منظمة التحرير في إيجاد اسلوب للتعامل مع الإسلام السياسي حين ظهر في الساحة السياسية كامتداد لحركة الإخوان المسلمين، وفشلت في إدماج حركة حماس في الجسم السياسي الوطني. وفي الوقت نفسه، فشلت حركة حماس في إعادة تعريف نفسها كحركة وطنية. وعندها باتت الحركة السياسية الفلسطينية تُعرَّف كحركة وطنية وإسلامية، بعد أن كانت تعرَّف سابقًا كحركة وطنية أو كثورة أو مقاومة فلسطينية.
دفعت الانتفاضة الأولى القيادةَ السياسيةَ إلى تشديد مركزة القرار بيدها، حتى إنها وقَّعت اتفاق أوسلو قبل نقاشه مع القوى السياسية والمجتمعية داخل فلسطين التاريخية وخارجها. أعطى اتفاق أوسلو المسوّغ السياسي والتنظيمي والفكري لتهميش المؤسسات الوطنية الفلسطينية الجامعة التي كانت قائمة، إذ اعتُبرَ عنوانًا لمرحلة جديدة هي بناء نواة الدولة الفلسطينية المستقلة. الاتفاق استثنى من الاهتمام الوطني الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وكان فلسطينيو الأردن قد أخرجوا مبكرًا من اهتمامات السلطة الفلسطينية التي اقتصر تعاملها مع الوجود الفلسطيني في الأردن كما هو في لبنان وسوريا والخليج وفي أوروبا وأمريكا على التعامل الشكلي عبر سفاراتها وممثلياتها في هذه البلدان.
لكن انسداد الأفق أمام مشروع إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة فعلية في الضفة والقطاع أفقد الحقل السياسي إمكانية أن يتشكل له مركزًا دولاتيًا (من الدولة) سياديًا، وهذا سرَّع في تفكك الحركة الوطنية. وساهم فوز حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي سنة 2006 وفرض سيطرتها الكلية على قطاع غزة في 2007 في انقسام سلطة الحكم الذاتي إلى سلطة على أجزاء من الضفة الغربية وأخرى في القطاع، وكلاهما محتلٌ وخاضع لسيطرة دولة استعمارية استيطانية تفرض سيطرتها الكاملة بالقوة على جانبي الخط الأخضر.
أسفرَ تفكك الحقل السياسي الوطني عن تداعيات مختلفة. فقد تلاشت المؤسسات الوطنية المُمثِّلة للكل الفلسطيني، وسادت النخب السياسية المحلية، وباتت القيادات تستمد "شرعيتها" من مواقعها الحزبية السياسية والتنظيمية الحالية أو السابقة، ومن التعاطي الدبلوماسي معها من طرف الدول والمحاور الإقليمية والمؤسسات الدولية. ومع تفكك الحقل، هيمن خطابٌ محلي وإقليمي ودولي يختزل فلسطين في الأراضي المحتلة عام 1967، أي الضفة الغربية وقطاع غزة، ويختزل الشعب الفلسطيني في أولئك الرازحين تحت الاحتلال الإسرائيلي، ممّا همَّش اللاجئين والمنفيين وأيضًا الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل. وصارت الأجهزة الأمنية تتمتع بثقل خاص في الضفة الغربية وقطاع غزة من حيث حجم العاملين فيها وحصتها من الموازنة العامة. وترسخت السمة الريعية للسلطتين من خلال الاعتماد على المساعدات والتحويلات الخارجية وتنامي تأثير رأسمال الخاص في اقتصادهما.
وطرأت كذلك تحولات بنيوية مهمة على التكوين الاجتماعي في الضفة الغربية وقطاع غزة. ومنها نمو طبقة وسطى واسعة نسبيًا نتيجة قيام مؤسسات وأجهزة في السلطة الفلسطينية تتولى مسؤولية قطاعات مثل التعليم والصحة والأمن والمالية والإدارة، ونتيجة تنامي اقتصاد خدماتي ومصرفي، وبفعل وجود عدد وافر من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجالات مختلفة. وجاء هذا التحول مقابل تراجع حجم الطبقة العاملة ووزنها. لقد أسفر الوضع الذي تشكل بعد تفاق أوسلو، وبخاصة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية (عام 1999) عن ثبات نسب عالية للبطالة، ولا سيما في أوساط الشباب والخريجين، واتساع مظاهر عدم المساواة بين فئات الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة. وترسخت أيضًا عقلية "الموظف" وحلَّت محل عقلية "المناضل". ورغم أن حركتي فتح وحماس تعرّفان بنفسيهما كحركتي تحرر وطني، إلا أن واقع الحركتين بات مرهونًا لمؤسسات حكومية تسيرها أنظمة تراتبية بيروقراطية أوامرية، وانصب تركيزهما على تحسين شروط بقائهما.
لم تتردد النخب السياسية والاقتصادية في استعراض امتيازاتها وثرائها تحت سماء احتلال استيطاني قاهر ومتغوّل. ولا بد من الإشارة إلى أن الطبقة الوسطى، في الضفة الغربية وقطاع غزة، تعي تمامًا أن استقرار وضعها المعيشي وأسلوب حياتها يرتبط على نحو مباشر وغير مباشر بوجود مؤسسات السلطتين (في الضفة والقطاع)، رغم أن غالبية السكان لا تزال عرضة للقمع والإرهاب والإذلال الذي تمارسه قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنون المسلحون، ويعانون بسبب افتقارهم إلى العيش الكريم والمستقبل المهني بالإضافة إلى غياب الحل الوطني عن الأفق المرئي. ولا يزال الحصار الوحشي المفروض على قطاع غزة (من قبل إسرائيل والنظام في مصر) يزداد شدة، تتخلله حروبٌ إسرائيلية مدمرة، ولا يزال التطهير الإثني بحق الفلسطينيين المقدسيين، سواء بالطرد أو سحب الرخص أو غيرها من الأساليب، مستمرًا بلا هوادة.
لقد هيأت هذه الظروف الوضعَ في مناطق السلطتين لحالة تفجر قابلة للاشتعال في أية لحظة. ولكن بما أن منظمة التحرير الفلسطينية والتنظيمات السياسية والقطاع الخاص ومعظم تشكيلات المجتمع المدني لم تحشد أو لم تستطع أن تحشد الجماهير لمواجهة الاحتلال، فقد غلبت على هبة الغضب المستمرة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015 السمةُ المحلية والفردية وافتقرت هذه الهبة إلى قيادة ورؤية وطنية موحدة.
أدى تفكك الحقل السياسي الفلسطيني إلى زيادة انكشاف التجمعات الفلسطينية لإجراءات التنكيل والتمييز المختلفة. فقد ارتفعت وتيرة تعرّض التجمعات الفلسطينية داخل فلسطين التاريخية وفي الشتات للتنكيل والتمييز، حيث يواجه فلسطينيو الأرض المحتلة عام 1948 فيضًا متناميًا من القوانين التمييزية، بينما يواجه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان وسوريا والأردن ومناطق أخرى تمييزًا وتنكيلًا. وعمومًا، تراجعت مكانة القضية الفلسطينية عربيًا ودوليًا، وقد تفاقم هذا الوضع جراء الحروب الداخلية والخارجية التي يشهدها عدد من البلدان العربية.
الثقافة تزدهر وتحتضن الهوية الوطنية
أضحى الشعب الفلسطيني اليوم بلا دولة ذات سيادة وبلا حركة تحرر وطني. ومع ذلك، تملك الوطنية الفلسطينية حيوية متميزة، ويعود الفضل في ذلك إلى دور الحقل الثقافي في الحفاظ على الرواية الفلسطينية وإثرائها. إن دور الحقل الثقافي في الحفاظ على الرواية الفلسطينية والانتماء الوطني القومي، دورٌ قديم ومتواصل. ففي أعقاب إعلان دولة إسرائيل في 1948 وهزيمة النخب السياسية والحركة الوطنية آنذاك، حافظت الأقلية الفلسطينية في إسرائيل على هويتها الوطنية والقومية من خلال نشاط الحقل الثقافي ولا سيما في مجالات الشعر والقصة والرواية والمسرح ولاحقًا الغناء والسينما. لقد سجل الكاتب والصحفي الفلسطيني غسان كنفاني هذا الدور المتميز مبكراً في كتابه "أدب المقاومة في فلسطين المحتلة 1948-1966" المنشور في بيروت عام 1968. ومن الشخصيات الأدبية الرئيسية التي ساهمت في الحفاظ على الهوية الوطنية وإثرائها الشاعر محمود درويش، والشاعر سميح القاسم، ورئيس بلدية الناصرة والشاعر توفيق زيَّاد، والكاتب إميل حبيبي، كما يتجلى في أعماله كرواية المتشائل وأيضًا في صحيفة الاتحاد ذات التوجه الشيوعي التي شارك في إنشائها. وحين أبقت إسرائيل مواطنيها الفلسطينيين تحت الحكم العسكري في عقدي الخمسينات والستينات، ساهمت الأعمال الأدبية والثقافية والفنية في تعزيز وحماية الهوية والرواية الوطنية الفلسطينية (والعربية)، حيث وصلت هذه الأعمال إلى جميع أنحاء العالم العربي وما وراءه، وساهمت، وما زالت، في إرساء صلات ثقافية جامعة بين مكونات الكل الفلسطيني وفضائه العربي.
لقد كان لفلسطيني 1948، كما درَجَ الخطاب الفلسطيني على تسميتهم، دورٌ متميزٌ في تعريف "الخارج" الفلسطيني والعربي بآليات ومحددات السياسة الإسرائيلية وتأثير الأيديولوجية الصهيونية في هذه السياسة. وساهم في هذا التعريف التحاقُ عددٍ من الباحثين والمثقفين الفلسطينيين من الأرض المحتلة عام 1948 بمراكز البحث الفلسطينية والعربية في بيروت ودمشق وغيرهما.
ومنذئذ، ظل الحقل الثقافي يوفر للفلسطينيين إمكانيات أرحب من الحقل السياسي، ولا سيما في أوقات الأزمات، للتواصل وبناء الأطر والنشاطات المشتركة الخارقة لحدود الجغرافيا السياسية في أجناس ثقافية عديدة تشمل الرواية والقصة والشعر والسينما والمسرح والفن التشكيلي والغناء والرقص الشعبي والفنون المعمارية، بالإضافة إلى الإنتاج الفكري بأنواعه من إبداعات كتاب ومخرجين وفنانين معروفين عالميًا ومواهب فتية من غزة والضفة الغربية. وتنتقل هذه الأعمال عبر وسائل عديدة منها وسائل التواصل الاجتماعي، ممّا يعزز الروابط بين الفلسطينيين أنفسهم وبينهم وبين أشقائهم العرب ويعزز تفاعلاتهم العابرة للحدود الوطنية.
حيوية الوطنية الفلسطينية تتغذى من الرواية التاريخية الفلسطينية بفصولها المتعاقبة والمتتالية ومن التجربة الحياتية، بيومياتها المعاشة في تجمعات الشعب الفلسطيني التي تقاسي الاستثناء والاحتلال والتمييز والنفي والحرب. ولعل هذه الحيوية هو ما يفسر محرك اندفاع الفتية والشبيبة، ذكورًا وإناثا، في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ونسبة كبيرة منهم ولدوا بعد اتفاق أوسلو عام 1993، وفي مناطق 1948، في مواجهات مع الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. ولعله يفسر أيضًا الجموع الغفيرة التي تشارك في تشييع جثامين الشهداء وفي التبرع لإعادة بناء بيوت أسر الشهداء التي تهدمها إسرائيل كعقاب جماعي خلال هبة الغضب الشبابية الحالية.
إن إبراز أهمية الحقل الثقافي ودوره الحيوي لا يعني إغفال ضرورةِ إعادة بناء الحقل السياسي الوطني على أسس تمثيلية وديمقراطية جديدة. وعلينا أن نتعلم من النقائص والقصور التي شابت الحقل السياسي السابق وأن نتجاوزها ونتوقف عن إضاعة الجهد والوقت والموارد في ترميم حقل سياسي تفكك واندثر. وعلينا كذلك أن نتخلى عن مفاهيم وممارسات دحضتها التجربة الوطنية، من قبيل المركزية المفرطة، إذ يجب أن تكون السياسة من شأن جموع الناس.
وعلينا أن نحمي ثقافتنا الوطنية من المفاهيم والمقاربات التي تستعبد العقل، وتشل التفكير والإرادة، وتربي التزمت، وتقدس الجهل، وتعلي شأن الخرافة والأسطورة. وينبغي لنا أن نتشبث بقيم التحرر الوطني، السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وبقيم الحرية والمساواة والعدالة.
نحن بحاجة إلى فهم جديد للعمل السياسي مغايرٍ تمامًا لما هو سائد. ويمكن لمح مؤشرات أولية عن الفهم الجديد المطلوب في ثنايا اللغة الآخذة في التبلور بين القوى الشبابية وفي العلاقة بين القوى السياسية الفلسطينية داخل الخط الأخضر. وهي لغة تشير إلى تعمق الوعي باستحالة التعايش مع الصهيونية كأيديولوجية عنصرية وكنظام استيطاني عنصري ينكر ويجرّم الرواية التاريخية الفلسطينية.
في صلب الوعي السياسي الناشئ تكمن ضرورة مشاركة التجمعات الفلسطينية، كحقٍ وواجب، في مناقشة السياسات الوطنية وصياغتها وإقرارها للكل الفلسطيني. ومن الضرورة بمكان أيضًا أن ندرك حقَّ كل تجمع منفرد في تقرير إستراتيجيته إزاء القضايا الخاصة به، وفي المشاركة في تقرير مصير مجمل الشعب الفلسطيني.
ولأن بناء حركة سياسية جديدة لن يكون أمرا سهلا نتيجة نمو مصالح فئوية، وبسبب الخشية من ممارسة الديمقراطية (كإجراءات وقيم)، فمن الضرورة بمكان أن نشجع المبادرات على صعيد كل تجمع لتشكيل أطر قيادية محلية - بمشاركة أوسع عدد ممكن من القوى وأفراد المجتمع ومؤسساته - على غرار جهود فلسطيني الأرض المحتلة عام 1948 في تنظيم انتخابات جرى لجنة المتابعة العليا لإدارة شؤون المجتمع المحلي والدفاع عن حقوقه ومصالحه، وعلى غرار ما جرى بين فلسطيني الضفة الغربية وقطاع غزة إبان الانتفاضة الأولى. ومن الأمثلة الناجحة لبنى وعي وتنظيم جديدين حركةُ مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، والتي توالف بين فصائل سياسية مختلفة ومؤسسات أهلية واتحادات خلف إستراتيجية ورؤية موحدة.
قد يرى البعض في هذا ضربًا من اليوتوبيا والمثالية، ولكننا أحوج ما نكون لها أمام الفوضى المجنونة والفئوية المفرطة في قصر نظرها محليا وعربيا. ونحن نملك تاريخًا عريقًا في العمل السياسي والإبداع الثقافي بوسعنا أن ننهل منه.
المصدر: شبكة السياسات الفلسطينية