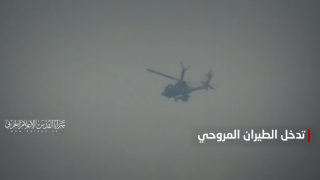فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: لم تكن الشهادة مجرد حلم عند إبراهيم الشهيد، بل كان رحمه الله عمليا، نشيطا متميزا، فذرع ثغور القطاع طولا وعرضا، لم يترك مستوطنة إلا رصدها وفكر فيها، ورفع إلى إخوانه فكرة اقتحامها، وأذكر هنا قصة حدثت معي: أخبرت إبراهيم الشهيد رحمه الله عن "هدف" أعجبني أفكر فيه، إذ أنني شاهدت في منطقة “المنطار” قافلة من ثماني سيارات، يمكن استهدافها بسهولة؛ إذ أن الأشجار كانت تصل إلى الخط الذي تمشي عليه القافلة.
لم يكن معنا نقود فطلبنا من الوالدة وأخبرناها الخبر، فسعدت بذلك جدا وأعطتنا ودعت لنا بالتوفيق. كنت في الخامسة عشرة، وكان إبراهيم في السادسة عشرة. ليست هنا القصة، بل القصة أننا في طريقنا صادفنا مجموعة من الأمن الوطني، أمسكوا بنا وقالوا: ماذا تفعلون هنا؟ فأجبت أنا: “بدنا نطبش حجار”. لا أخفيكم أنني ارتبكت قليلا. فسألانا عن أسمائنا: فأجاب إبراهيم رحمه الله، باسمين من تأليفه، عني وعنه، وكان يومها قوي الشخصية، ظهرت رجولته الحقة عند الامتحان. فقالوا له: “انخمد”، وطلبوا مني أن أجيب على الأسئلة. "لقد استهملوني" فشعرت حينها بالمسئولية، وصرت أجيب بقوة.. وخرجنا من ذلك الامتحان سالمين. وأكملنا طريقنا.. أعطاني إبراهيم رحمه الله حينها درسا في ضرورة التماسك وسرعة البديهة، درسا عمليا أتبعه بدرس نظري. المهم.. أنا "نمت على روحي"، وهو بقي يبحث، كان الأمر بالنسبة له فوق الجدّيّ، وأرسل لإخوانه يرجوهم بكل وسيلة، يستحلفهم بالله، ويبكي لهم. لم يكن أمامهم إلا الاستجابة له، بعد تدخل والدي -الشهيد نزار ريان- لصالحه.
 لم يطل الأمر على إبراهيم حتى وُجِد الهدف، فأُخذ ودُرِّب، وتم التجهيز لعملية كانت أول عملية اقتحام لمستوطنة في انتفاضة الأقصى.
لم يطل الأمر على إبراهيم حتى وُجِد الهدف، فأُخذ ودُرِّب، وتم التجهيز لعملية كانت أول عملية اقتحام لمستوطنة في انتفاضة الأقصى.
كان ثمة غموض يكتنف الأمر حينها بالنسبة لقيادة الكتائب، وأخبرني الشيخ صلاح شحادة رحمه الله بذلك شخصيا. كان كل من في بيتنا يعلم أن إبراهيم خارج لعملية استشهادية، كنا جميعا تيقنا من ذلك، بما في ذلك الوالدة، التي كانت مشجعة له ولغيره، وكانت –حفظها الله- أول خنساء في تاريخ فلسطين، ترسل ابنها إلى الموت وهي به عالمة، ولم يسبقها إلى ذلك أحد فيما أعلم. خرج إبراهيم إلى عمليته ثلاث مرات، المرة الأولى ذهب ولم يكن الوضع مناسبا، أما الثانية فنام هو ورفيقه على أعتاب المستوطنة أربع ساعات، حصلت للشهيدين إغفاءة عجيبة، لا يعلمان كيف حصلت لهما سوية بالتزامن، ثم لما عادا في المرة الأخيرة التي نفذا العملية فيها، وجدا سرادقات منصوبة للاحتفال بذكرى إقامة المستوطنة، فكان نومهما يومها وعودتهما سببا في حصول العملية في أجواء أفضل بكثير، والثالثة كانت "نابتة"، كما يقول أهلنا. في المرتين الأوليين كان رحمه الله يعود ويحدثنا عما حدث معه، وعندما عاد في المرة الثانية، كنت قد بت ليلتها مهموما.. وسهرت بانتظار خبر شقيقي، لكنه لم يستشهد، بل عاد عند الفجر، وحين رأيته.. أقسم بالله أنني قلت كلمة لا أشعر إلا وكأنها ألقيت في فمي، قلت له: “لسة مش مستشهد.. بديش أسلم عليك” فلما سمعها إبراهيم.. أشرق وجهه، وارتفعت معنوياته إلى أعلى مستوى، وابتسم ابتسامة ساحرة، رغم ما كان يبدو عليه من مشقة وتعب. لم يلبث إلا أن خرج في اليوم الذي يليه، وفي ذلك اليوم كان موعده مع الشهادة، كنت يومها في حفل لتكريم حفظة القرآن الكريم، عدت من هذا الحفل ومعي شقيقي الأصغر عبد القادر، فسمعت في الطريق أخبار عملية اقتحام عسكرية، فأسرعت إلى المنزل، فوجدت على باب دارنا صديقي الشهيد بلال فايز شحادة، فسألني بلهفة: أين إبراهيم؟ فقلت له: ليس بالبيت، فضرب بيده على جبينه، وكاد يبكي. دخلت منزلنا بخطوات متثاقلة، فوجدت أهل بيتنا يحتشدون، صعدنا جميعا إلى السطح وجلسنا نرقب العملية، كانت أصوات الانفجارات والاشتباكات تطربنا حقا، وكانت الإذاعات تعلن عن القتلى والجرحى تباعا، وكنا نستبشر عند كل قتيل من العدوّ وجريح، كانت معركة حقيقية، استمرت نحو خمس ساعات، ثم بدأت المعركة تهدأ شيئا فشيئا، وتكثف تحليق طائرات الأباتشي، فنزلنا إلى التلفاز، وفتحنا على الجزيرة، لم يكد كل منا يجلس في مكانه، إلا وشريط الجزيرة يكتب خبرا عاجلا، باستشهاد منفذي العملية، إذ كان مع إبراهيم استشهادي آخر استشهد معه.
 لم أكد أقرأ الشريط، حتى سمعتُ زغرودة مدوية، لم أكن أسمعها فقط، بل والله لكأنني أنظر إليها تضرب الجدران، وتطوف على آذاننا وتتردد، لا أكذب إن قلت: إن زغرودة والدتي لحظة استشهاد إبراهيم لا تزال ترن في أذني حتى الآن. ثم علا البكاء والنحيب، وكلنا بكى سوى والدي كان يثبت القلوب ويجبر الكسور، -جزاه الله عنا خير الجزاء-، الغريب حينها أن عيني خذلتني فما أنزلت دمعة، بكيت بلا دموع، ودون أن يراني أحد. كانت العملية ناجحة فوق الحدود، قتل فيها ثلاثة صهاينة ثم لحقهم رابع، وجُرح أكثر من عشرين، حسب اعتراف الاحتلال، وكان لها صدى كبيرًا. في الصباح أعلن خبر استشهاد إبراهيم في مسجدنا، ولم يكن يبلغ حينها ستة عشر عاما وعشرة أشهر وسبعة عشر يوما، فكان أصغر استشهادي في تاريخ كتائب القسّام حتى الآن. واجتمع الناس على باب دارنا، فجاء شقيقي الأكبر، واشترى أكياس حلوى، وصار يرمي على رؤوس الناس، ثم أطلق النار في الجو فرحا باستشهاد إبراهيم. تم تسليم جثمان الشهيد، وانطلق الأهل إلى المشفى ليحضروه، لا أعلم كيف سبقوني، لكنني لحقت بهم، في السيارة عرفني نساء معسكرنا، فلما رأينني رمقنني بنظراتهن وبكين على الشهيد، وصرت في حال لا أحسد عليه. في طريقي إلى المشفى قابلت قافلة عائدة، كانت سيارات العائلة تحمل جثمانه، نزلت من السيارة، فلما رآني أعمامي، أوقفوا السيارة التي تحمل الشهيد، وركبت معهم.
لم أكد أقرأ الشريط، حتى سمعتُ زغرودة مدوية، لم أكن أسمعها فقط، بل والله لكأنني أنظر إليها تضرب الجدران، وتطوف على آذاننا وتتردد، لا أكذب إن قلت: إن زغرودة والدتي لحظة استشهاد إبراهيم لا تزال ترن في أذني حتى الآن. ثم علا البكاء والنحيب، وكلنا بكى سوى والدي كان يثبت القلوب ويجبر الكسور، -جزاه الله عنا خير الجزاء-، الغريب حينها أن عيني خذلتني فما أنزلت دمعة، بكيت بلا دموع، ودون أن يراني أحد. كانت العملية ناجحة فوق الحدود، قتل فيها ثلاثة صهاينة ثم لحقهم رابع، وجُرح أكثر من عشرين، حسب اعتراف الاحتلال، وكان لها صدى كبيرًا. في الصباح أعلن خبر استشهاد إبراهيم في مسجدنا، ولم يكن يبلغ حينها ستة عشر عاما وعشرة أشهر وسبعة عشر يوما، فكان أصغر استشهادي في تاريخ كتائب القسّام حتى الآن. واجتمع الناس على باب دارنا، فجاء شقيقي الأكبر، واشترى أكياس حلوى، وصار يرمي على رؤوس الناس، ثم أطلق النار في الجو فرحا باستشهاد إبراهيم. تم تسليم جثمان الشهيد، وانطلق الأهل إلى المشفى ليحضروه، لا أعلم كيف سبقوني، لكنني لحقت بهم، في السيارة عرفني نساء معسكرنا، فلما رأينني رمقنني بنظراتهن وبكين على الشهيد، وصرت في حال لا أحسد عليه. في طريقي إلى المشفى قابلت قافلة عائدة، كانت سيارات العائلة تحمل جثمانه، نزلت من السيارة، فلما رآني أعمامي، أوقفوا السيارة التي تحمل الشهيد، وركبت معهم.
فوجئت بشقيقي، ممددا بينهم، جثمانا نهشه الرصاص نهشا، حينها بكيت.. بل أقسم أنه لو جمعت دموعي كلها قبل استشهاده ثم وزنت بما نزفته حينها لعادت ضئيلة. بكيت ومسحت على رأسه، فصادفت رصاصتين كانتا مختبئتين في مقدمة شعره. فازداد بكائي. أشفق علي الحاضرون، فصاروا يذكرون من عبارات التصبير والتهوين، والتذكير بالله، فصحت بهم: “كل ما تقولونه أنا أخبر منكم به” فدعوني وشأني، حينها نظر إلي عمي أبو عبيدة رحمه الله –وقد استشهد فيما بعد- وقال لهم وهو يبكي: “اتركوه” .. لقد قرأ ما في قلبي.. ونعمّا فعل. بكيت حينها كما يحلو لي، ثم لما أردنا أن ندخل المنزل، مسحت دموعي، ودخلنا، فزغردت أمي أخرى، وقالت: “أهلا وسهلا يمّه”. وقالت: “لا إله إلا الله .. محمد رسول الله.. عليها نحيا .. وعليها نموت.. وعليها نلقى الله".