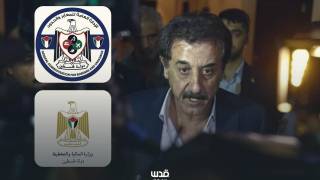خاص - شبكة قُدس: لم يعد الفلسطيني في الضفة الغربية بحاجة إلى دليل ليدرك أن حياته اليومية محاصرة بالبوابات الحديدية والحواجز العسكرية. فالانتقال من بلدة إلى أخرى تحوّل إلى رحلة شاقة تمر عبر أكثر من ألف حاجز وبوابة تقطع أوصال الضفة إلى جيوب صغيرة معزولة يعيش داخلها أكثر من ثلاثة ملايين إنسان. خلال العام الأخير تصاعدت سياسة الإغلاقات بشكل غير مسبوق، حتى باتت تفاصيل الحياة الاجتماعية والاقتصادية مرهونة بإرادة الاحتلال وإجراءاته الميدانية.
تشير إحصائيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل القرى والمدن الفلسطينية بأكثر من 900 بوابة عسكرية، فضلاً عن عشرات السواتر والمكعبات الأسمنتية والحواجز التي تحولت تدريجيًا إلى بوابات حديدية دائمة. الهدف من هذه التبديلات، كما توضح الهيئة، هو ترسيخ واقع طويل الأمد من الحصار والعزل يصعب تغييره مستقبلاً.
النتيجة المباشرة لهذه السياسة هي مضاعفة معاناة الناس. فالمسافة التي لم تكن تستغرق أكثر من عشر دقائق باتت تحتاج إلى ساعة أو أكثر، حيث يضطر المواطنون إلى سلوك طرق التفافية عبر القرى الجبلية لمسافة قد تتجاوز ثلاثين كيلومتراً. التنقل داخل المحافظة الواحدة أصبح مغامرة محفوفة بالانتظار والإذلال على البوابات، فيما تبدو الحرية في الحركة مجرد استثناء مشروط بقرار الجنود.
التحكم بالمكان عبر البوابات ليس جديدًا؛ إذ تعود جذوره إلى الانتفاضة الثانية حين نصبت سلطات الاحتلال بوابات حديدية عند المداخل الرئيسية وبين الأراضي المصادرة والمزارع المعزولة، وسمحت للمزارعين بالمرور وفق تصاريح خاصة. في القدس مثلاً، جرى استخدام هذه البوابات لعزل بلدة الجيب أو تقييد الدخول إلى بيت إكسا والنبي صموئيل بتصاريح محددة. لكن وتيرة نصب البوابات تسارعت في العامين الأخيرين بشكل لافت، وبات الهدف أبعد من مجرد السيطرة الأمنية، إذ تسعى “إسرائيل” إلى تفتيت الجغرافيا الفلسطينية وإخضاعها لنظام مراقبة دائم بأقل عدد من الجنود، في ظل الاستنزاف البشري الذي يعانيه جيش الاحتلال.
بهذا المعنى، تتحول البوابات الحديدية إلى ما يشبه تصريحًا جماعيًا للتنقل داخل الضفة، وتجسيدًا لعودة نظام الحكم العسكري الذي عرفه الفلسطينيون داخل أراضي 1948، حيث لم يكن التنقل ممكنًا إلا بإذن خاص وضمن أوقات محددة. وهي أدوات ردع تهدف إلى تقليص قدرة الفلسطينيين على تنظيم أنفسهم أو مواصلة المقاومة، إذ يدرك الناشطون أن المرور عبر أي حاجز قد ينتهي بالاعتقال.
الأثر الاقتصادي لهذه السياسة لا يقل خطورة. دراسة حديثة صادرة عن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) تقدّر أن الفلسطينيين يخسرون يوميًا نحو 191 ألف ساعة عمل بسبب الطرق الالتفافية والإغلاقات، أي ما يزيد على 4.2 مليون ساعة شهريًا، تعادل 526 يوم عمل على مستوى سوق العمل. هذه الخسائر تترجم ماليًا إلى نحو 2.8 مليون شيقل يوميًا، أي أكثر من 62 مليون شيقل شهريًا، بافتراض 22 يوم عمل.
كما تتكبد وسائل النقل العمومية كلفة إضافية باهظة نتيجة استهلاك الوقود. فالمسافات الإضافية الناجمة عن الحواجز تتراوح بين 9.5 و17.5 كيلومترًا للرحلة الواحدة، ما يؤدي إلى استهلاك نحو 66 ألف لتر وقود شهريًا بكلفة تتجاوز 1.5 مليون شيقل. الأثر هنا لا يقتصر على السائقين وأصحاب المركبات، بل ينعكس على مجمل الاقتصاد عبر رفع تكاليف الإنتاج، وزيادة أسعار السلع، وأحيانًا تلفها قبل وصولها للأسواق.
لكن الصورة لا تتوقف عند الاقتصاد. فالحواجز والبوابات هي أداة لإعادة تشكيل المجتمع الفلسطيني جغرافيًا واجتماعيًا. فهي تفصل القرى عن محيطها، وتقطع التواصل بين المدن، وتعزز في المقابل حرية حركة المستوطنين على الطرق الالتفافية المحصّنة. بهذه الطريقة يتحول القيد الأمني إلى سياسة استراتيجية لتكريس نظام فصل عنصري يجعل الفلسطينيين محاصرين داخل “كانتونات” مغلقة، بلا تواصل طبيعي، وبلا قدرة على بناء حياة اقتصادية واجتماعية مستقرة.
إنها سياسة تقوم على خنق المكان والزمان معًا: عزل الجغرافيا، واستنزاف الوقت، ومفاقمة الكلفة. والبوابات الحديدية، بكل ما تمثله من عزل وتحكم، ليست مجرد أداة عسكرية، بل جزء من منظومة تهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني وتحويله إلى جماعات محاصرة داخل جزر منفصلة، وهو ما يعكس جوهر المشروع الاستعماري الإسرائيلي في الضفة الغربية.