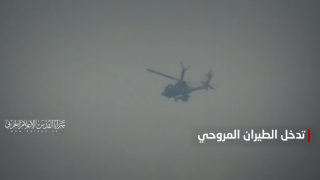منذ أن أصدر الرئيس محمود عباس القرارات بقانون ٣٩، ٤٠، ٤١ لسنه ٢٠٢٠، تلك المتعلقة بتشكيل المحاكم النظامية، و تعديل قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة ٢٠٠٢، وانشاء المحاكم الإدارية، عزمت على الكتابه بالشأن المذكور. وآثرت الكتابة في غير تلك الأوقات التي اعتدت أن أكتب فيها ما عُهد به إلي من قرارات وأحكام، وأن تكون الكتابة على حساب راحتي وراحة أسرتي، يومَ الجمعة.
وليستقيم لي الحديث، أُسجلُ أن قانون السلطة القضائية رقم ١ لسنة ٢٠٠٢، حالة متقدمة على غيره من القوانين في العالم العربي بما يضمن استقلال السلطة القضائية ومبدأ الفصل بين السلطات، منوهاً أن تشكيل المجالس القضائية في العالم لا يجري فيه الأمر على نسق أو وتيرة واحدة.، ولن أشغل القارئ بالتفاصيل الدقيقة، لكن القول الحق بأن تشكيل المجالس القضائية في العالم العربي، التي يكون فيها رئيس مجلس القضاء الأعلى الملك أو رئيس الجمهورية، أو وزير العدل أو تضم في عضويتها وكيل وزارة العدل، تعصف بمبدأ الفصل بين السلطات وتُجرد القضاء من أهم ضمانات إستقلاله.
إلآ أن هنالك خلافاً في الرأي حول مجالس القضاء التي تتضمن ممثلين عن البرلمانات، أو نقابة المحامين، أو عمداء كليات الحقوق، أو منظمات المجتمع المدني المهتمة بالشأن القضائي والحقوق والحريات وسيادة القانون، واختلاف الرأي فيما أرى، مَردُّه الواقع المُعاش في كل دولة، ومساحة الحقوق والحريات، والديمقراطية، والثقافة المجتمعية ومدى الوعي القانوني، اذ أن ما يصلح في بلد ما لا يصلح في بلد آخر ... لكن هذا كله مرتبط بقواعد قانونية ودستورية.
وعودٌ على بدء، فقد أصدر الرئيس محمود عباس بتاريخ 15/ 7/ 2019 ، القرارين بقانون رقم 16 و 17 لسنة 2019، وقد تضمن القرار رقم 16 تعديلاً لشروط إشغال منصب رئيس المحكمه العليا ونائبه، و تعديلاً لسن تقاعد القضاة من 70 الى 60، فيما تضمن القرار بقانون رقم 17 حلاً لمجلس القضاء الأعلى، وكافة هيئات المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي، نيط به -وعلى النحو الذي صيغ به- اصلاح وتطوير السلطة القضائية والنيابة العامة، و مُنح صلاحيات واسعه في سبيل هذا الذي( كُلف به) - والذي نراه وأفصحنا عنه مرارا ً - وعلى ما أنبأت عنه أحكام القانون الأساسي بوصفه القانون الأسمى، و قانون السلطة القضائية، رقم 1 لسنه 2002، والمبادئ والمواثيق والأعراف القانونية ، والاتفاقيات التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية (دولة فلسطين)، وألزمت بها ذاتها، بأن المجلس المنعوت (مجلس القضاء الأعلى الانتقالي) ،جاء على خلاف كل ذلك من حيث انشائه وتشكيله ونعته وشخوصه وصلاحياته، وقد جاء معيبا مشوها معتلاً، وأن عيبَه وتشويهه وعلته انحدرت به الى درجة الانعدام، ويُعاذُ بالقضاء الدستوري والإداري أن يُشرعنَه.
وقد تبع ذلك قبل أيام من انتهاء المده الممنوحة للمجلس الإنتقالي وما تبعها من تمديد، صدور القرارات بقانون 39، 40 و41 المشار اليها استهلالاً.
وبعطف النظر على القرارات المذكورة فإنها تشترك مع سابقاتها (القراران ١٦، ١٧ لسنة ٢٠١٩)، مخالفتها للقانون الأساسي ولمبدأ الفصل بين السلطات والأعراف والمواثيق الدولية، ومنهج ضوابط التشريع، اذا أنها ُفُصّلت بالمقاس، بعيداً عمّا يجب أن تتصف به القاعدة القانونية من تجرد وعمومية، وفوق ذلك وقبله وبعده قُصد بها إحكام قبضة السلطة التنفيذية ومتنفيذيها من الأجهزة الأمنية على السلطة القضائية، و مزيداً من الهيمنة والتغول والاستقواء، وخلق حالةٍ من التزاوج غير مسبوقه بين السلطتين... وهدم والغاء مبدأ استقلال القضاء، والعبث في قانون سيادي، جاء مُنظِما لعمل واحدةٍ من أهم السلطات، تلك الأمينة على الأرواح والأموال والسلم الأهلي ... بما تقرره من أحكام وُصفت بعنوان الحقيقة، ضماناً للاستقرار والحكم الرشيد.
ذلك أن السلطة القضائية هي سلطة دستورية في كافة النظم الحديثة، يحرص واضعوا الدستور على أن يتضمن الدستور المبادئ العامه التي تحكمها، حتى لا تقوم سلطة أخرى بتشريعها فتبدو هذه السلطة أدنى مرتبه، وأقل شأنا وأسيرة لها، بما ينال من استقلالها.
وقد جاء القانون الأساسي، متضمناً تلك المبادئ.. فيما جاءت القرارات بقانون مجافية لروحه وأحكامه، وقد عبثت بكامل ضمانات استقلال التكوين المؤسسي، ممثلا بمجلس القضاء الأعلى، و معلوم بالضرورة أن ثمة أمرين متلازمين لا استقلال للسلطة القضائية إلا بهما، أولهما التكوين المؤسسي، وثانيهما تكوين القاضي الإنسان، علماً أن الثاني يسبق الأول، ذلك أن القاضي الذي ليس له بين جنبيه عزة القاضي، وكرامة وغضبة القاضي لسلطانه واستقلاله، ليس أهلا ليكون قاضياً، وبحكم اللزوم أيضا ليس أهلاً أن يكون أحد أعضاء التكوين المؤسسي، وبذلك كل من سعى ويسعى أو تزلف أو وسط ليكون في موقع قيادة السلطة القضائية، باعَ نفسه للشيطان ولا يصلح ان يكون قاضياً، بل إن القضاء أُبتلي به، وهو وصمة عار وسبة في جبين القضاء، ولا يعدو أن يكون أداة أو دمية يُحركها من عينَه، متى شاء وكيف شاء.
وفي ذلك نجد أن القرار بقانون 40، نص على أن يُعيّن رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض، وتُقبل استقالته بقرار من رئيس دولة فلسطين، بعد تنسيب المجلس لعدد ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية.. وفيما نرى أن التنسيب على النحو المذكور لا يغدو أن يكون صورياً، كما أعفى رئيس المحكمة العليا /محكمة النقض، من نطاق القيد المتعلق بالسن، ناهيك عن تمييزه عن غيره من القضاة فيما يتعلق بحساب الراتب التقاعدي، وشروط استحقاقه، وكذلك استحدث ما يُعرف بالاستيداع والإحالة على التقاعد، وِفق لجنة مشكلة بقرار من مجلس القضاء الأعلى، وكذلك الأمر بالنسبه لمجلس التأديب، والذي يُشَكل بقرار من المجلس أيضا، كما تَوسع في صلاحيات رئيس المجلس بالانتداب وأخضع القاضي للتجربة عند تعيينه، لمدة ثلاث سنوات، على أن تسري بأثرٍ رجعي بحق القضاة اللذين تم تعيينهم قبل نفاذ القرار بقانون.
وكذلك استحدث ما عُرف بالقاضي المتدرج، وضرب بعرض الحائط كامل المراكز المكتسبة للقضاة، ومبدأ الأقدمية، وغدا الرئيس مرؤوساً والمرؤوس رئيساً.
كما أنه وفي القرار رقم 41 المتعلق في المحاكم الادارية أحكم السيطرة على قضاتها، بحيث يتم أول تعيين لرئيس ونائب رئيس المحكمة الإدارية وقضاتها، ورئيس المحكمة الإدارية العليا ونائب رئيس المحكمة الإدارية العليا وقضاتها، بقرار من الرئيس بعد التشاور مع رئيس مجلس القضاء ووزير العدل، فيما يُعين رئيس المحكمة الإدارية العليا، وتُقبل استقالته بقرار من الرئيس.
ولعل من الواجب أن نشير أن قاضي القانون العام ( القاضي الاداري والقاضي الدستوري)، يتمتع بسلطة واسعةٍ في نطاق ما يُعرض عليه من خصومات، اذا ان له دوراً مباشراً في صناعة القاعدة القانونية واجبة التطبيق، وازاء هذا الدور المنشئ لقاضي القانون العام، تبرز أهمية الأحكام التي تُصدرها المحاكم الإدارية والدستورية في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، وفي تعزيز الحقوق والحريات، حتى غدت القواعد القانونية والادارية مستوحاة من أحكام القضاء الإداري ، كما أن الأحكام الدستورية تعد من مصادر القانون الرسمية، ولا عاصم لأحدٍ منها، ومن هنا يظهر و يبرز دور القضاء في إصلاح النظام السياسي أو تعميق سطوته واستقواءه.
وبذلك يتضح أن القرارات بقانون المشار إليها وما سبقها 16 و17، هي صناعة قائمة على أسس بعيده كل البعد عن ضوابط العمل التشريعي، ودون مراعاةٍ لولاية القضاء بل تُفصح - وعلى النحو الذي صيغت به-، بأن ضابطها الولاء والطاعة والاستئناس والاحتواء، وقد صيغت في غرفةٍ مظلمة وبسرية عالية تفوق سرية صناعة أسلحة الدمار الشامل (وهي كذلك)، رافقها منافعٌ متبادلة، ومصالحٌ متضاربة بين كل من ساهم في صناعتها، حُسمت بحسب طاقة ونفوذ كل منهم، مستغلين هوى جامح وشهوة عارمة... وارتفاعاً في مستوى الأنا.
كما ساهم في صناعتها شهوة الانتقام، وتصفيةَ الحسابات ورغبة جامحه، وشهوه عارمة لمن يُعِد نفسه ليكون هو الخليفة المنتظر بعد حين، رئيسا للمحكمه العليا، و/أو رئيسا للمحكمة الاداريه العليا.
ويُلاحظُ على نحو واضح أن تجمعات القضاة تلك التي تخرج عن نطاق التكوين المؤسسي الرسمي، بصرف النظر عن تسمياتها (جمعية، نادي، نقابة)، قد أُخرجت وأُبعدت عن غايتها، وأُحكمت السيطرة عليها، ( إذ نُص على أن يُنشأَ للقضاة العاملين والمتقاعدين نادي اجتماعي، ثقافي، تنظم احكامه بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية)، وفي ذلك اخلال بحق ضمنته المواثيق والأعراف الدولية ، إذ من حق القضاة تكوين الجمعيات والانضمام اليها وفق ما نُص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وفي ميثاق الأمم المتحدة، وفي العهد الدولي للحقوق السياسية والاجتماعية، وفي الميثاق الافريقي لحقوق الانسان، وفي الإعلان العالمي لاستقلال القضاء والمحاماة ، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985، والمعروف بإعلان ميلانو، ومبادئ بنجلور للسلوك القضائي.
هذا غيض من فيض.
وكلما أمعَنت النظر تَبيَّن لك مزيداً من العوار... وأرجو أن يكون للحديث بقية...