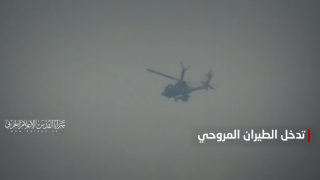أثارت حادثة ذبح لاجئ مسلم مدرسا في فرنسا الكثير من الجدل في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وهو جدل ذهب باتجاهات شتى: سياسية وثقافية ودينية. فواقعة القتل؛ بل الذبح، التي قام بها فردٌ -سواء أفتى لنفسه أم أُفتي له من قبل جهة ما- تفتح النقاش على مسائل عديدة، منها مثلا: نمط العلمانية الفرنسية المغلقة وإشكالاتها ومدى قدرتها على الانفتاح وقبول التنوع والتعددية، وموضوع الاندماج وقدرة المسلمين على العيش في ظل ثقافات مغايرة لمعتقداتهم، ومفهوم حرية التعبير واختلاف المنظور القيمي لها، وإدارة الاختلاف الديني والعقدي والاجتماعي، والعلاقة بين الموروث الفقهي والواقع المعاش خاصة في أوروبا، والأخلاق وصلتها بالفقه (فنحن أمام فعل ذبح يتم اعتباره فعلا شرعيا معبرا عن الغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم)، والعلاقة بين المعتقد الديني واحترام القانون، والواجبات على المسلم في الدول غير الإسلامية سواء كان مواطنا أم لاجئا، وغير ذلك.
وقد أمكن لهذا الفعل أن يفتح النقاش حول كل هذه الموضوعات وغيرها؛ لأن له سياقات ثقافية واجتماعية وسياسية أوسع، سواء على المستوى المحلي (فرنسا) أم على مستوى العلاقة بين النص الديني والتاريخ والواقع، ومن ثم فإن التركيز على موضوع واحد من الموضوعات السابقة مفهوم بل مشروع، ولا يمكن ادعاء أولوية موضوع على آخر من الناحية الفكرية والمنهجية؛ إلا إذا كنا سنسلك طريقة تسييس الأفعال، بمعنى أن يتم توظيف واقعة معينة لخدمة أهداف سياسية عامة لا تتصل بالواقعة نفسها أو ليست هي العامل الوحيد فيها، أو لنصرة أفكار عامة عن الإرهاب الإسلامي أو استعمارية فرنسا وعدائها للدين.
فالفعل له أخلاقياته الخاصة به، أما الحدث فله مناقشة مختلفة بوصفه رواية يمكن نقدها وتحليلها ومقارنتها بالروايات الأخرى (إن وجدت)، ثم تحليله من جوانبه المختلفة، والتأمل في أسبابه القريبة والبعيدة، والعوامل التي تسهم في صناعته
ولتوضيح الفكرة السابقة أقترح هنا التمييز بين الفعل والحدث، فالفعل وتقويماته ينشغل بها حقلا الفقه والأخلاق من الناحية المعيارية؛ بغض النظر عن تفاصيل الحدث ورواياته، وهذا التمييز بين الفعل والحدث يتصل بالتمييز الضروري -المسلَّم به في حقلي الفقه والأخلاق- بين الفعل المجرد (الأحكام والمبادئ المطلقة عن الزمان والمكان والأشخاص) والفعل المعيّن (الفتوى الخاصة بفعل شخص معين في زمان ومكان معينين)، ويفصل بين الفعل المجرد والفعل المعين مسافة واسعة من الاجتهاد والتعليل أولا، ومن الإجراءات اللازمة في حقل التطبيق ثانيا. وهذه الإجراءات تتصل بأفعال الأفراد الذين يتحملون مسؤولية أفعالهم من جهة، ووظيفة القانون من جهة أخرى الذي يملك الحق في العقاب والتجريم.
فالفعل له أخلاقياته الخاصة به، أما الحدث فله مناقشة مختلفة بوصفه رواية يمكن نقدها وتحليلها ومقارنتها بالروايات الأخرى (إن وجدت)، ثم تحليله من جوانبه المختلفة، والتأمل في أسبابه القريبة والبعيدة، والعوامل التي تسهم في صناعته. لنتأمل مثلا محاولات التشكيك في القاتل/الفاعل عبر الزعم بأن الحدث صناعة مخابراتية فرنسية، أو تلك التي تلتمس للفعل مسوغات سياقية تتعلق بالتهميش الاجتماعي ومشكلات الاندماج، أو الذهاب إلى مدى أبعد عبر القول -مثلا- إن الإنصات إلى الرواية الفرنسية عن الحدث هو خضوع لمنطق القوة. وهذه محاولات لا تعدو أن تكون التفافا لتبرير ما جرى؛ لأنها في المحصلة تقفز فوق الفعل نفسه وتجعله هامشيا لصالح حدث وسردية أكبر منه.
وفي المقابل على الطرف الفرنسي، ثمة محاولة للزج بالإسلام كدين أو بـ"الإسلامية" كحركة في سياق الحدث، ومحاولة لوضع حدث جنائي في سياق "الإرهاب"؛ بحيث يتحول إلى مركب بين ما هو سياسي وأمني. وهذه لا تعدو محاولة للاستثمار السياسي في الفعل، الذي يتم تحويله إلى مناسبة للتمييز ضد ديانة أو فئة من المجتمع عبر القفز من مستوى فعل قام به فرد محدد إلى مستوى حدث عام يتم الزج فيه بجماعات وديانة وثقافة بأسرها، وبين هذين الموقفين على الطرفين سنكون أمام تأجيج مستمر لهذا التوتر، ومرده في رأيي إلى الخلط بين الحدث والفعل.
يتسم الحدث بالتعقيد والتركيب، والسياق جزء صميم منه، ومعالجته تكون محاولة للفهم والتفسير أولا، ولوضع سياسات تعالج جذوره وتحاصره أو تمنع من تكراره، وتحدد المسؤوليات عن مسبباته في إطار أوسع من مجرد الفعل والفاعل المباشرين. أما الفعل فله أخلاقياته الخاصة به، ومردها إلى التقويم المعياري له والخوض في التعليلات اللازمة لتصنيفه فعلا صالحا أو غير صالح. كما أن إدانة فعل القتل -مثلا- لا تعني قبول فعل الرسوم الكاريكاتيرية أو الاعتراف بصواب عرضها في سياق تعليمي؛ لأن لكل فعل تقويمه الخاص به، والخطأ لا يسوغ الخطأ وإن قاد إليه، والانفعالات ليست مسوغا أخلاقيا لجعل الفعل غير الصالح صالحا. ويكمن الإشكال هنا في أن من يثنون على فعل القتل يرون فيه الفعل الوحيد الملائم للتعبير عن معتقدهم في إدانة عرض الرسوم، وربما ذهب بعضهم إلى تسويغ القتل من خلال القول إن القتل رد فعل على استفزاز؛ في محاولة للتخفيف من إدانة القتل نفسه.
يتغاضى مؤيدو القتل -بوصفه الجزاء الأوفى على الرسوم أو عرضها- عن أن فعلهم هذا من شأنه أن يفتح النقاش مجددا حول أمرين مركزيين هنا:
(1) السؤال الأول: ما الأفعال التي تستوجب القتل؟ وما مفهوم الإساءة هنا؟ وماذا لو اختلفنا في تقرير ما هو إساءة؟ فمثلا تحيل بعض تفاصيل الواقعة الفرنسية إلى أن قصد الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم غير موجود؛ لأنها تأتي في سياق تأويلي عن (حرية التعبير)، ويؤكد ذلك أن المدرس نفسه طلب من الطلاب المسلمين مغادرة القاعة حتى لا تتأذى مشاعرهم، ففي حال انتفاء قصد الإساءة يتحول الفعل إلى ما يعبر عنه الفقهاء بأنه "صاحب تأويل"، ثم إن عرض الرسوم يحتمل معانٍ مختلفة، بعضها أيضا لا يتضمن الإساءة إذا كان بهدف شرح حساسيات مثل هذه الرسوم وأثرها على اختلاف المنظور القيمي حول ما نسميه حرية التعبير والفارق بينها، وبين إهانة المعتقدات والرموز، وفي هذه الحالة سينطبق على فعل العرض قاعدة أن ناقل الكفر ليس بكافر، وفي كل الأحوال لا نملك أي تفاصيل عن هذا السياق حتى نحكم عليه من الناحية النظرية، بغض النظر عن دوافع القاتل وتعديه على القانون وعلى نفس غيره.
اعلان
(2) والسؤال الثاني: من الذي يحكم في مثل هذه الحوادث؟ وما المرجعية فيها؟ وهل هي متروكة للأفراد وخياراتهم وانفعالاتهم ومن ثم يصبح لا معنى للقانون والمجتمع والدولة؟ وهل يحق للفرد (سواء كان مواطنا أم غير موطن) أن يخل بالتزاماته القانونية التي أقر بها بموجب جنسيته أو بموجب التأشيرة التي دخل بها إلى بلد ما؟
لا تقف مناقشة الفعل وأخلاقياته عند حدود تقويم فعل الذبح الذي وقع وانتهى؛ لتحديد موقف منه بعد وقوعه، بل تشمل -أيضا- تصورات الناس عن هذا الفعل، ومرجعياتهم في تقويمه، وتعليلاتهم له، وتحديدا مخاطبة من يُثنون على هذا الفعل ويصنفونه عملا بطوليا؛ لأن تمجيد الفعل وإضفاء شرعية دينية وأخلاقية عليه سيشجع على تكراره، وهذا سيترك آثاره على العديد من المسائل التي افتتحت بها مقالي هنا.
أدانت مؤسسة الأزهر الشريف والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وغيرهم ذلك الفعل واعتبروه جريمة محرمة، وقد ضم بعضهم إلى ذلك إدانة الرسوم الكاريكاتيرية، التي تشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما يلفت النظر أن هذه الإدانات تأتي على شكل بيانات، وليس فتوى مؤصلة توضح مستنداتها وحججها التي تستند إليها
ويجب أن نستحضر هنا أن الإقدام على فعل ما أو الثناء عليه إنما يُسبق باعتقاد إلا إذا كان فعلا عابثا؛ فالثناء على فعل الذبح يعني أن الفعل يمكن أن يتكرر إن توفر له السياق المناسب. وهذا فارق آخر مهم يوضح أهمية المعالجة الفقهية والأخلاقية للفعل، وأنه لا يجوز الغض عنها أو الزعم بأنها هامشية؛ لأنها تتصل بأخلاقيات الأفعال وما يعده الناس فعلا صالحا أو غير صالح، ومن هنا اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز لمسلم أن يُقدم على فعل ما (ولو كان مختلفا فيه) ما لم يعتقد فيه اعتقادا واضحا، فإن أقدم على فعله مع شكه في حله وحرمته أثم. هكذا يتضح أن تقويم الفعل له أبعاد وآثار اجتماعية وقانونية وأخلاقية ودينية واسعة بعيدا عن الانفعالات ومحاولات التسييس والتسييس المضاد.
ومما يعطي للجانبين الفقهي والأخلاقي أهمية في هذه الواقعة وجود موقفين: الأول مؤيد لواقعة الذبح والآخر متسامح مع الفعل أو متفهم له في أدنى تقدير؛ وهذان الموقفان يحيلان إلى وجود اعتقاد -يسود لدى بعض المسلمين- بأن القاتل إنما طبق حكما إسلاميا واجب التنفيذ؛ لنصرة الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم، وربما أخذ هذا مع آخرين صيغا مثل اعتباره حدثا يظهر عزة المسلم ويشفي صدور قوم مؤمنين، أو أنه ثبات وشجاعة في زمن اضطهاد المسلمين والاستخفاف بهم إلى غير ذلك، وكثير من هؤلاء المشجعين يكتفون بدور المراقب من بعيد طالما أن المسألة لن تكلفهم سوى انفعالات وتعليقات فيسبوكية.
ولكن في المقابل أدانت مؤسسة الأزهر الشريف والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وغيرهم ذلك الفعل واعتبروه جريمة محرمة، وقد ضم بعضهم إلى ذلك إدانة الرسوم الكاريكاتيرية، التي تشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما يلفت النظر أن هذه الإدانات تأتي على شكل بيانات، وليس فتوى مؤصلة توضح مستنداتها وحججها التي تستند إليها، وتعلل بها موقفها، الذي ربما تعتبره موقفا أخلاقيا وإنسانيا بدهيا، كما أنها لا توضح موقفها من الموروث الفقهي في هذه النقطة، وهذا لا يمكن تجاهله، ولا أعرف جهة إفتاء ساندت الفعل أو استدلت له فقهيا. ومن المفارقة أن تأييد فعل القتل والاستدلال له لإضفاء شرعية عليه إنما وقع من بعض جمهور وسائل التواصل الاجتماعي، سواء عبر قص ولصق أحاديث نبوية وأخبار تاريخية تؤيد عقوبة القتل لمن يسب النبي صلى الله عليه وسلم، أو عبر اعتبار أن حكم القتل هو حكم الإسلام الذي لا يقبل النقاش؛ لأنه بمنزلة البدهيات الإسلامية التي تعبر عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم والغيرة له؛ ومن ثم فإن أي مناقشة لهذا الحكم أو ذلك الفعل إنما تعكس -في زعمهم- عدم الغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم.
ويجسد هذا الاستعمال الشعبي لنصوص الحديث والفقه في مقابل اكتفاء الجهات الرسمية بإصدار البيانات جزءا من المشكلة، وقد ساهم التوجه الأثري المعاصر الذي أرسى دعائمه الشيخ ناصر الدين الألباني -رحمه الله- في سيادة هذه النزعة التقنية في بناء الأحكام، وهي نزعة تقوم على الانتقائية والشكلانية من دون محاولة الفهم والتعليل، وتفترض أن النصوص واضحة بنفسها، وما علينا إلا تطبيقها، كما ساهمت الجهادية المعاصرة في إحياء مفاهيم العالم القديم (كدار الكفر ودار الإسلام) ووضعتها موضع التنفيذ من قبل أفراد وتنظيمات معينة.
يلتقي تأييد جريمة قتل المدرس الفرنسي مع منهج حركات العنف من حيث إنه ينتصر لحكم الأفراد وتصرفاتهم في المسائل التي تتصل بالسلطة والقضاء، ومن ثم فإنه يؤيد الخروج على منطق الجماعة والدولة والقانون؛ لمجرد اختيار فردي أو تنظيمي؛ رغم أن اتفاق الفقهاء على أن مثل هذه الأحكام -إن ثبتت- فمردها إلى الفتوى من الناحية الديانية، وإلى القضاء من الناحية التنفيذية
لا يمكن تجاهل الموروث الفقهي في هذا الشأن وغيره، فالمسألة تحتاج إلى معالجة تتفاعل مع إشكالات الواقع المعاصر من جهة، وتقدم فهما متماسكا للفقه الموروث من جهة ثانية، وتعي تبدلات سياق الفقه في الأزمنة الكلاسيكية وسياق الدولة الحديثة من جهة ثالثة، وحتى يتسنى ذلك فنحن بحاجة إلى أبعد من مجرد الوقوف عند حديث هنا أو أثر هناك، خصوصا أن ثمة أحاديث ووقائع متعارضة بعضها يشير إلى عقوبة القتل، وبعضها يشير إلى العفو وإهمال الساب، ولم ينفِ الفقهاء صحة تلك الأحاديث والوقائع؛ ولكنهم خاضوا في تأويلاتها، وإذا كان بعضنا سينتقي أحاديث العفو، فإن الآخرين قد انتقوا أحاديث القتل وسندور في حلقة مفرغة.
يُخيّل لمن يتابع استدلالات الفسابكة وغيرهم على قتل المدرس الفرنسي أن على المسلمين أن يلاحقوا أي محاولة إساءة أو انتقاص لنبي الإسلام -صلى الله عليه وسلم- على وجه الكرة الأرضية، وأن ينفذوا فيه حكم القتل بغض النظر عن أي قانون أو اعتبار، ويخيل إليه أن المسلمين جميعا يأثمون إن لم يفعلوا ذلك؛ رغم أن من يراجع كتب الفقه ووقائع التاريخ يجد المسألة أشد تعقيدا من هذه التصورات المجتزأة والمختزلة، فضلا عن أن أحكام الشريعة لا تُلزِم غير المسلمين والخاضعين لقوانينهم، ومن المفارقة أن هناك اتفاقا -من الناحية الفقهية- على أن حكم سب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كحكم سب سائر الأنبياء، فإذا كانت المسألة مردها إلى حكم فقهي -بزعمهم- فلماذا يتم تجاهل الإساءة إلى سائر الأنبياء؟
يلتقي تأييد جريمة قتل المدرس الفرنسي مع منهج حركات العنف من حيث إنه ينتصر لحكم الأفراد وتصرفاتهم في المسائل التي تتصل بالسلطة والقضاء، ومن ثم فإنه يؤيد الخروج على منطق الجماعة والدولة والقانون؛ لمجرد اختيار فردي أو تنظيمي؛ رغم أن اتفاق الفقهاء على أن مثل هذه الأحكام -إن ثبتت- فمردها إلى الفتوى من الناحية الديانية، وإلى القضاء من الناحية التنفيذية، ولهذا نص ابن تيمية في مقدمته لكتاب "الصارم المسلول على شاتم الرسول" أن "المقصود ههنا بيان الحكم الشرعي الذي يفتي به المفتي ويقضي به القاضي"؛ لأن الحكم المعين لا بد من إثباته بفتوى وإقامته ببينة يقضي بها القاضي على من يَلزمه، ولذلك وجدنا أن مسألة سب الرسول -صلى الله عليه وسلم- تصنف في كتب الفقه ضمن أبواب تتصل بمسائل الدماء والحدود والردة والذمة ونقض العهد والجزية، ما يعني أنها من مسائل الفتوى (مجرد بيان الرأي الشرعي) والقضاء (تنفيذ الحكم والإلزام به)، وليست من مسائل الأفراد، كما أنها ليست محلا لوجهات نظر العامة، وقد يجتمع فيها الديني والسياسي بحسب الفاعل ومكان الفعل. فالفاعل هنا والمؤيد له حوَّلا الحكم والتنفيذ إلى خيارات فردية؛ بحجة غياب القائم بأمر الله والمنفذ لشرعه، الذي يعتقدون وجوب إقامته بغض النظر عن جهة الاختصاص، وهذا منهج داعش والجهاديين عامة.
يساعدنا هذا التمييز بين الفعل والحدث على الوعي التركيبي وتجاوز الشعبويات السائدة، فأفعال مثل الإساءة، والقتل، وتأييد القتل بمسوغات فقهية قديمة أو بأفكار حديثة، وإدانة ديانة القاتل أو مجتمعه ووصمها بالإرهاب… يجب التعامل معها بدقة وتجزيء وعدم وضعها في سلة واحدة؛ إذ إن فعلا منها لا يسوغ الفعل الآخر، والخطأ لا يسوغ الخطأ؛ لأننا في هذه الحالة سنغرق في دوامة من الأخطاء الدائرية، وسيفقد النموذج الأخلاقي معياريته التي بها توزن الأفعال. كان هذا المقال بمنزلة المقدمة النظرية لمناقشة التصورات الفقهية حول ساب الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف يمكن أن نفهمها، وهو ما سأخصص له مقالا آخر بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الجزيرة